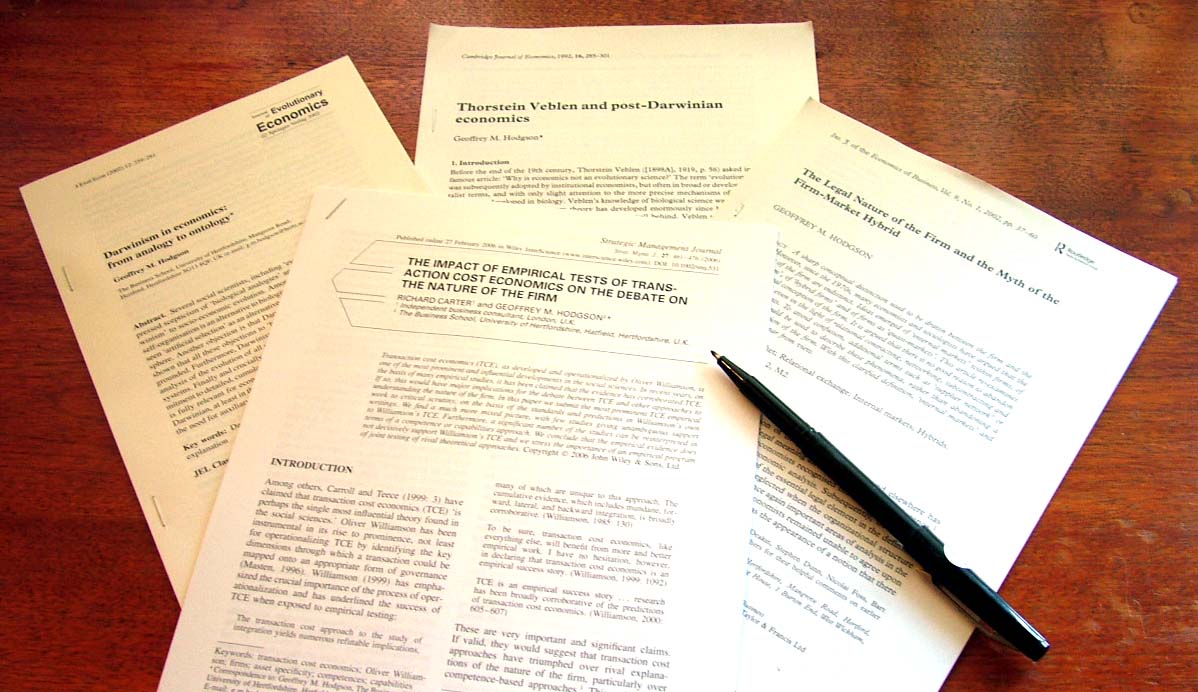
"أقول : الحياة التي لا تُعّرف إلا بضد هو الموت ليست حياة !!" (محمود درويش قصيدة طباق).
هل حفلت الثقافة العربية بالصراع بين الأدب والفلسفة؟ أو على الأقل هل حفلت برؤية قائمة على تضاد بين الاثنين؟
الإجابة عن هذا السؤال تحتاج إلى دراسة وتنقيب يبحث في التقاطعات والتشابهات والتداخلات والتضادات بين كل منهما ، وليس من السهل الاجتراء على جواب متسرع ، لكن يمكننا أن نلاحظ أنه في كثير من الأدبيات والرؤى السائدة ثمة ما يشبه الاقتناع بأن طريقة تفاعل الأديب مع الوجود وقضاياه تختلف في طريقة عرضها (الكتابة) عن الطريقة التي يكشف بها المفكر أو الفيلسوف عن القضايا ذاتها ، وربما يؤول كل منهما إلى النتائج نفسها ، وإن اختلفت طرق كل منهما. ولكن هل الوعي بهذه المسألة مطروح على نحو همّ وجودي أم على نحو همَ جمالي خاصة أن قناة التوصيل في كلا الحالتين واحدة (اللغة والكتابة) ، ولاسيما أن الكتابة نفسها حتى في حال الفلسفة متهمة أيضاً بأنها غير خالية من "الخيال والمجاز.حتى لقد بين جورج لايكوف ومايكل جونسن في كتابهما ( الاستعارات التي نحيا بها ) كيف تتغلغل الاستعارة واللغة الشعرية إلى معقل كل الممارسات اللغوية التي تظن نفسها محصنةً وعلمية ومنهجية بعيدًا عن البنى الاستعارية ، ويكشف عن أن كل ذلك مجرد وهم . ويقول د. عبدالسلام بنعبد العالي في هذا السياق : " كل محاولات فصل الفلسفة عن الأدب وتأكيدها بوصفها خطابًا عن حقيقة تنطق بذاتها وتتمتع بامتيازات وتعفى من أهواء الكتابة لابد أن تصطدم بالواقع الفوار بالتشكيل النصي للفلسفة ، هذا ما ستؤكده جمهرة من المفكرين بدءًا من نيتشه إلى جاك دريدا. كل هؤلاء سيقولون إن الفلسفة تتحدد بنتاجها الذي يتحقق في الكتابة وأنها تخضع مثل أي كتابة للتدفق الدلالي غير المحكوم ، وأن مفاهيمها تستند إلى مجازات متوازية ، وأنها لا يمكن أن تتصور خارج المجال النصي المتحقق بحسب دريدا ." ([1])
هذا المأزق الوجودي وهم التشكيل والهم الجمالي الملتبسان بمسألة الخلود والبقاء والممكن والمستحيل كل ذلك يحضر بقوة في حضرة المرض والموت . وهذه المعاني تحتشد في أسئلة تتراصف وأجوبة تموج بحيرتها في نص درويش (طباق) الذي يضيف إليه عنوانًا متفرعًا موضحًا أنه عن إدوارد سعيد. وهو عنوان يثير التساؤلات منذ البداية فما هو الطباق هنا ومع من ولمن؟ ذلك ما لا يجيب عنه النص مباشرة , حتى إن كلمة طباق لا ترد في النص , ولكن مجمل النص يقص قصة الطباق في سرد شعري متماسك يتحاشى أن يبكي أو يرثى. ولا شك أن شاعرًا كدرويش يستحضر مفكرًا كإدوارد سعيد لابد أن يكون منشغلاً بشيء غير البكاء والنواح الذي ألفناه في قصائد الرثاء ، إذ سنرى أنه مشغول بقلق وجودي كبير أكبر من حادثة الموت : هو مشغول في (طباق) بما يسميه الحق في اقتسام الرواية .
وحتى نستمتع بما في نص (طباق) من جماليات ودلالات يحسن أن ننتبه إلى أن الطباق في علم البديع هو (الجمع بين لفظين متضادين في معناهما) . لكن الطباق في عرف محمود درويش في هذه القصيدة يبدو أوسع بكثير، إنه إشكالية وجود وقلق هوية . و لذلك لا غرو أن تحتشد في القصيدة المتناقضات والمتضادات في تقابل مستفز للتساؤلات ومثير لمتعة التأمل . لكن التضاد الأكبر بين الموت والحياة هو التضاد المتوقع طبعًا من قصيدة قد يظن أنها تأبينة أو رثائية فإذا بالموت يغيب وتحضر الحياة برموزها الكبرى . لكن ثمة تقابلاً وتضادًا مضمرًا لا تقوله القصيدة مباشرة ذلك هو التضاد والتقابل بين درويش وإدوارد ، ويكشف نسيج القصيدة هذا المضمر مع كل مقطع من مقاطعها جزءًا من هذا التقابل بين الشاعر والمفكر إذ يستهمان قلق الوجود وقلق الهوية بينهما .
يبدو المشهد عند بداية المقطع الثاني من القصيدة بداية مفترق طرق لكل من إدوارد ودرويش، وتكشف بقية المقاطع عن سلسلة من الاختلافات الظاهرية الهشة , لكن تتوالى رغم الاختلافات انكشافات في اتحاد الهم والمصير ؛ حتى يبدو إدوارد ليس سوى الوجه الآخر من درويش في تكامل قصي طالما ردده درويش في قصائده عن آخره المنشطر. يقول درويش في ذلك المشهد الافتتاحي :
" قال كلانا
إذا كان ماضيك تجربة
فاجعل الغد معنى ورؤيا
لنذهب
لنذهب إلى غدنا واثقين
بصدق الخيال ومعجزة العشب ."
ولكن درويش بعد هذا العهد تباغته الشكوك ويعلنها صراحة , حينئذ تتخذ القصيدة في مسارها الطباقي والتضادي مسارًا ملحوظًا يركز على التقابل بين الروائي (كنوع من تحاشي ذكر الشاعر مباشرة) وبين المفكر أو الفيلسوف ، وسيسمع على بُعد جملة واحدة من العهد السابق بالسير بثقة نحو الغد هنودًا قدامى ينادون : " لا تثق بالحصان ولا بالحداثة " ثم " لا ضحية تسأل جلادها هل أنا أنت؟ " وبين الجلاد والضحية تبزغ الهوية وسلسلة من الانشطارات والتمزقات ، (هل يلوح هنا الغرب المتمركز جلادًا؟ ربما) .
وتسير القصيدة نحو ما يشبه المناظرة بين الروائي والمفكر لمناقشة أو لمعايشة أسئلة الوجود والتحدي والهوية ، وعلى رأسها السؤال المنصرم عن الجلاد والضحية . يقول درويش :
" يد الفرضية بيضاء مثل ضمير
الروائي حين يصفى الحساب مع
النزعة البشرية... لا غر في
الأمن، فلنتقدم إذًا
قد يكون التقدم جسر الرجوع
إلى البربرية . "
يبدو السؤال ملحًا وجارحًا خاصة مع قضية الاغتراب والمنفى تلك التي عاشها كل من درويش وإدوارد ، ولذلك بعد أن يفرد في القصيدة مساحة لما يشبه السيرة لجزء من يوميات إدوارد وحياته واختياراته ، وبعد أن كان السرد بضمير المتكلم على لسان إدوارد يطرح درويش سؤال الهوية ، ولا يبدو السؤال موجهًا بأهميته وفداحته إلى إدوارد سعيد بقدر ما يبدو نوعًا من المواجهة الشرسة مع الذات الدرويشية ، تلك الذات التي واجهت مرات كثيرة المرض وتماست مع الموت ، وربما هي تتراءى في مصير الآخر وفي صورته ، يقول :
" والهوية؟ قلتُ
فقال : دفاع عن الذات...
إن الهوية بنت الولادة ولكنها
في النهاية إبداع صاحبها، لا
وراثة ماضٍ أنا المتعدد.. في
داخلي خارجي المتجدد. لكنني
أنتمي لسؤال الضحية. لو لم أكن
من هناك لدربتُ قلبي على أن
يربي هناك غزال الكناية...
فاحمل بلادك أنى ذهبت وكن
نرجسيًا إذا لزم الأمر
منفى هو العالم الخارجي
ومنفى هو العالم الباطني فمن أنت بينهما ؟ "
هكذا يمكننا أن نلحظ أن هذا الطباق الممتد في مجاز موسع عبر القصيدة الطويلة ليس سوى مواجهة بين جانبين من شخصية واحدة تتناقض ولكنها تتكامل ، حتى إننا نفقد في أجزاء من القصيدة القدرة على تبين من يخاطب من ؟ هل يخاطب درويش إدوارد ؟ أم أنه شخّص جانبًا من ذاته وراح يمطرها بأسئلته . يقول في مقطع عند منتصف القصيدة :
" هل كتبت الرواية؟
حاولت..... حاولت أن استعيد
بها صورتي في مرايا النساء البعيدات
لكنهن توغلن في ليلهن الحصين ."
إلى أن يقول :
" ضحكت على عبثي
ورميت الرواية
في سلة المهملات
المفكر يكبح سرد الروائي
والفيلسوف يشرح ورد المغني . "
منذ سؤال الهوية السالف والشاعر أو الروائي سارد النص وصانع الحوار يتخذ موقف المحاور الذي يستجوب إدوارد ويستوضحه . منذ سؤال الهوية والذات تتلامح في صراعاتها واختياراتها وتضاداتها . ويظهر إدوارد بصورة من يعطي الأجوبة ودرويش يقود دفة القصيدة/ السؤال أو القصيدة الأسئلة ، لكنها (أي القصيدة) تتخذ طابعًا آخر مختلفاً عن المطالع الأولى الافتتاحية التي أدخلت كل من الروائي والمفكر إلى المشهد الشعري كل بحلته الخاصة ورؤاه . هذا الطابع الجديد الذي يتسرب فيها بدءًا من سؤال الهوية عند منتصفها تقريبًا هو تلك الروح الرثائية الخفية التي يؤلمها الفقد , ولكنها لا تنوح وتؤبن ، وإنما تظهر عبر صور ومشاهد حاسمة من تاريخ إدوارد الشخصي وتحديدًا إنتاجه المتعلق بذاته الإنسانية التي كتبها على شكل سيرة ذاتية سماها (خارج المكان) . وطبعًا هنا ثمة تحيز للبعد السردي والروائي في شخصية إدوارد على حساب بعد المفكر فيه ، يقول درويش :
" والحنين إلى أمس؟
عاطفة لا تخص المفكر إلا
ليفهم توق الغريب إلى أدوات
الغياب....
ألم تتسلل إلى أمس حين
ذهبت إلى البيت بيتك في
القدس في حارة الطالبية؟
هيأت نفسي لأن أتمدد
في تخت أمي كما يفعل الطفل
حين يخاف أباه، وحاولت أن
استعيد ولادة نفسي ، وأن
أتتبع درب الحليب على سطح بيتي
القديم وحاولت أن أتحسس جلد
الغياب ورائحة الصيف من
ياسمين الحديقة لكن ضبع الحقيقة عن حنين تلفت كاللص
خلفي. وهل خفت؟ ماذا أخافك؟
لا أستطيع لقاء الخسارة وجهًا
لوجه. وقفت على الباب كالمتسول . "
يحاصر – كما ترى – درويش مُحاوره بالزيارة وبمحاولة اكتشاف الذات في رحلة العودة ، ويتضح من سرد الروائي ، أو من سرد درويش للحادثة ، فداحة الازدواج وفداحة السؤال التالي : أيهما يجدي أكثر الشعر أم الفلسفة ؟ يقول درويش :
" لا أنا أو هو
ولكنه قارئ يتساءل عما
يقول لنا الشعر في زمن الكارثة ؟"
بعد هذا السؤال المليء بالجدل والغصص يمضي درويش يستل خيط الشعر من بحر الدم إلى أن يصل إلى ما يشبه نهاية المناورة بين الشعر والفلسفة في زمن الكارثة ، ويضع الجواب على لسان إدوارد , محاوره ، يقول :
" يقول القصيدة قد تستضيف
الخسارة خيطًا من الضوء يلمع
في قلب جيتاره أو مسيحًا على
فرس مثخنًا بالمجاز الجميل، فليس
الجمالي إلا حضور الحقيقي في الشكل ."
إلى أن يقول :
" واصرخ لتسمع نفسك
واصرخ لتعلم أنك ما زلت حيًا
وحيًا وأن الحياة على هذه الأرض
ممكنة ، فاخترع أملاً للكلام
ابتكر جهة أو سرابًا يطيل الرجاء
وغن فإن الجمالي حرية ."
هكذا يتسلل رويداً رويدًا الجمالي ليعلن انتصاره على لسان خصمه وهذا ما يبرر تكرار درويش على لسان إدوار مقولة الخلود . ويختم درويش القصيدة بدفاع إدوارد عما يسميه الحق في اقتسام الرواية , وهنا لايبدو السرد أو الرواية مجرد نوع جمالي من الأدب كما قد يتبادر إلى الذهن في سياق هذه المناظرة الطويلة بين الروائي والمفكر بل يظهر مغزى درويش من كلمة الرواية والحق في صنع التاريخ وسرده أو إعادة كتابة هذا الحق فيه والدفاع عن هذا الحق ، يقول :
" عندما زرته في سدوم الجديدة
في عام ألفين واثنين كان يقاوم
حرب سدوم على أهل بابل
والسرطان معًا ، كان كالبطل الملحمي
الأخير يدافع عن حق طروادة
في اقتسام الرواية ."
هنا تحديدًا يدرك القارئ أن المفكر لا يكبح سرد الروائي وأن الفيلسوف يشرح ورد المغني لأنهما يستهمان الحق نفسه : حق رواية الوجود !!
[1] - ينظر مقالة عبد السلام بنعبد العالي بعنوان ( دريدا وكونديرا : الأدب والفلسفة على تقاطع طرق ) جريدة الحياة ، العدد ( 15118 ) الأربعاء 18 أغسطس 2004م الموافق 2 رجب 1425هـ .