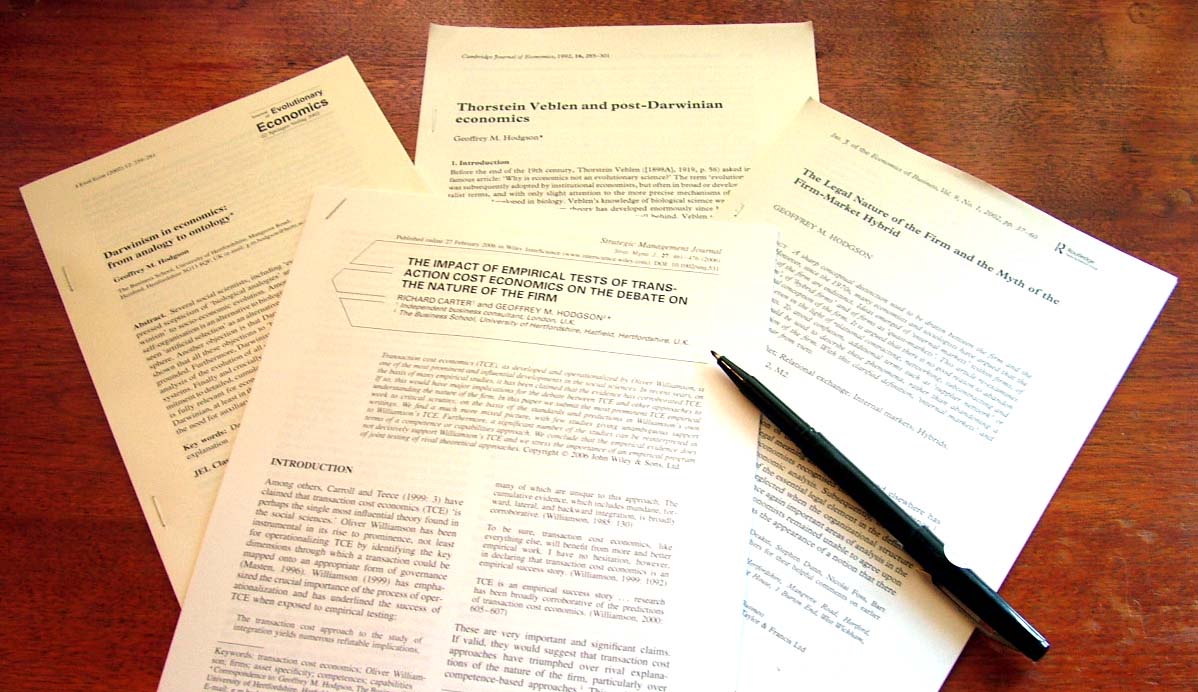
المرض فوضى في نظام الجسد ، فعلى أية مرتكزات تأتي اللغتان ( لغة الجسد وجسد اللغة ) تسعيان لضبط الفوضى ، وتحت أي منطق ووفق أية سلطة واستنادًا إلى أي خطاب تتحركان ؟ هذا باختصار ما يحاول أن يبديه هذا العرض الذي يعمد إلى جمع بعض المتفرقات التي تتوقف عند عادة أو تقليد أسري له ما يناظره عند بعض شعوب العالم ، وتمر بجزء من حكاية خرافية مشابهة ، وبنتف متفرقة من موروث أدبي ، وبعض أقوال تعكس معتقدات وسلوكيات تجاه اللغة والوجود . وهي متفرقات تلوح فيها تيمة الشفاء سواء في سياق لغة الجسد أم جسد اللغة . ولا أعرضها لمجرد وجود التيمة ، وإنما لالتقاءات ومشابهات في العلة والموقف والوظيفة ، كما سنرى . فمعظم هذه النصوص والأقوال والعادات تعمل في منطقة الحاجة والسلب , وتأتي لغة الجسد ( القبلة واللمسة والنفثة والرائحة ) أو جسد اللغة ( الآيات والتعويذات والحروف المطلسمة .. ) لتُمرّر عبر صيغ معينة ما نقص وغاب ؛ لتُستدعى وتحضر الكينونة الغائبة ، ويستعاد حضورها كاملة صحيحة مـعافاة .
فـكلمة ( بين ) في العنوان لا تعني التعارض والمقارنة ، إذ من المهم النظر إليها مربوطة بما قبلها ( تيمة الشفاء ) التي ستجد طريقها عن طريق لغة الجسد وبشكل متواز ومتماهٍ أحيانًا مع جسد اللغة . فـ ( بين ) في العنوان تشير إلى مسعى اقتناص تيمة الشفاء في التشابهات والتداخلات أيضًا بين اللغتين من أجل تحقيق وظيفة التيمة المشار إليها ، التي تعكس ، فيما تعكس ، هذا التلاحم بين الأشياء والأسماء .
ومن هنا سيكون تركيز الدراسة على الدور الذي تؤديه التيمة في مختلف النصوص لإيضاح المرتكز الإيديولوجي والديني والميثيولوجي ، في محاولة لإبراز ملمح السكوت عنه الذي يختفي تحت الممارسات الترميزية المفصح عنها . هذا الملمح هو الخط الذي أحاول أن أحفر عنه ، لأعود به ، كلما أمكن ذلك ، إلى جذره المقدس والديني والأسطوري .
ولذا فإن هدفًا أساسيًا من هذا الاستعراض لهذه التيمة كما تتجلى في ممارسات لغة الجسد وجسد اللغة يتضح هنا بالضبط : في محاولة تسليط الضوء على بعض الروابط والعلاقات في معرض واحد تحت النظر مشدودة إلى بعضها ، أملاً في إثارة التساؤل حول هذه العلاقات وما تعكسه هذه الممارسة من رؤى مشتركة للإنسان والحياة .
وهذا الاستعراض التحليلي لهذه المنظومة من إشارات النصوص يطمح إلى تعرية هذه الممارسات في محاولة للبحث عن منطقها الداخلي وفتح بعدها الدلالي ، حتى تتحقق قراءة نظام إحالاتها الضمنية متفرقة ومجتمعة إلى خطابها الخاص , الذي يحيل إلى رؤية نفسية وواقعية ومعرفية تلتحم بالوجود في شقيه الأساسيين : اللغة والإنسان ، على محوري لغة الجسد وجسد اللغة في مواجهة أضداد الحياة .
أولاً : لغة الجسد :
1- رائحة القميص/ لغة الخلاص :
يتعرف الإنسان في الطفولة على العالم من حوله من خلال الحواس والملاصقة الحميمة للأشياء . يتعلم لغة الجسد الفصيحة والمبهمة وإيحاءاتها العميقة ، والرائحة لغة الجسد الأولى ، بل هي أعرق وأقدم لغة يدركها الطفل في بداية علاقته بالعالم من حوله قبل اللمس والنظر والمناغاة والكلام . وهو يعي وجود أمه ، أول ما يعيه ، عن طريق الشم . رائحة الأم هذه التي تمثل حال التصاقها به للرضاعة مؤشر أمان ومصدر حياة . أليست هي مصدر غذائه واستمرار حياته ، تقضي بالتصاقها به على قارص الجوع ونازع الخوف والفزع ؟ إذًا ليست الرائحة بعيدة عن معنى الخلود والامتداد وليست بعيدة عن معنى الجنان .
ولا أنسى توقفي مرات ومرات حينما كانت تبالغ في التحبب إلى العمةُ الكبرى فتقول ( يا ريح أمي وبوي) ، وهذا القول جزء من التعبير الشائع لدى بعض الجدات والأمهات حينما يتذكرن أبناءهن ، أو حينما يدللنهم صغارًا كانوا أم كبارًا بـ ( يا ريح أمي ) أو ( يا ريح أبوي) حيث يتحول الوجود العيني والتجسد الماثل للطفل أو للابن إلى استحضار مَن مضوا ، يتحول إلى استحضار للماضي في محاولة لدرء الفقد والانفصال عبر هذا الامتداد بهم . إن هذا الحضور الماثل ، وهو الرائحة المعنوية ، أمام الجد أو الجدة ، يسترجع الرائحة (لغة الجسد الأولى) حيث لم يكن ثمة إلا تواصل واتصال ، وكأنها الحبل السري الذي لم يتبخر .
ولكن ترى ما الذي يستحضره هذا التعبير الذي يعيش ويتردد في حياة بعض الناس ؟ ليست العلاقة بين الرائحة والعماء غريبة ؛ فالطفل الوليد يكون في حالة شبه عماء ، ولا يعرف أمه ، وهي أول مدركاته في الوجود ، إلا عن طريق الشم . إننا لو تأملنا إيحاءات هذه اللغة ومدلولاتها المتبادلة في جدلية واضحة بين الأم وصغيرها لأمكننا بإحساس مرهف مفتوح أن نعود إلى جذر بعيد ، هو قصة يعقوب مع رائحة قميص ابنه يوسف عليهما السلام ، تلك الرائحة التي عملت عملاً سحريًا في رد بصر الشيخ الذي عميت عيناه من بكائه على ابنه ، وقد ارتد إليه البصر لمجرد شمه رائحة القميص ، رائحة جسد يوسف ، القميص الذي شم رائحته وقد أقبلت به القافلة وبينه وبينها مسافة ثمانين فرسخًا ، وبينه وبين فقده ليوسف ثمانون سنة كما يقول معظم المفسرين ([1]).
إن التأمل في إيحاءات تلك اللغة العتيقة ومدلولاتها التي تتكرر في حياة الناس يوميًا تجعلنا بإحساس مرهف مفتوح نسترجع قصة ارتداد بصر يعقوب – عليه السلام – إليه لمجرد شمه رائحة يوسف – عليه السلام - العالقة بالقميص ، هذه اللغة التي علقت لا في الأنف فقط بل في الروح والوجدان . وهذه اللغة ربما تجعلنا نتقبل وجدانيًا دون حاجة إلى سحرية ما أو معجزة ما لتصديق ما حدث ، أو إلى قول بعض المفسرين بأن القميص الذي أرسله يوسف – عليه السلام - إلى أبيه كان القميص التعويذة الذي لبسه إبراهيم – عليه السلام - حين ألقي في النار ، وأن جبريل أرسل به من الجنة إلى يوسف – عليه السلام - وهو في الجب ، ولذلك ففيه ريح الجنة ، ولأنه كذلك ولأنه القميص التعويذة ومن الجنة فهو لا يُلقى على مبتلى إلا عُوفي([2]) .
فهذا القميص المتوارث ، القميص التعويذة ، لم يختف تمامًا بقيت منه حتى الآن منه الرائحة، فصارت اللغة رائحة القميص ، والقميص رائحة اللغة ، صارت التعويذة التي علقت بسحر الكلام حينما يتحول من عاديته في التعبيرات اليومية المعتادة ، وينزاح إلى دلالاته البعيدة التي تطرد برائحة الحبيب ( حضورًا أو استحضارًا بذكرى ) خوف الفقد أو الفراق وأنواع الشرور والقضاء . ومازال البشر يتوارثون القميص ، ويعودون لحالة المهد والعماء ، ويخرجون منها بالرائحة . إنهم باللغة/ القميص وبالقميص/ اللغة مازالوا يخلعون الوجود والحياة ويلبسونها درءًا للموت والانفصال عن وحدة الحياة والأحياء ([3]).
فهل أبالغ إذا قُلت إن ثمة صلة بين الرائحة والروح ، وهي ليست مجرد صلة في الجذر اللغوي ، وإنما صلة تماهٍ ما بين الرائحة والروح ، الروح / الكلمة ، الروح كلمة الخلق وطاقة الإحياء الغامضة ، الروح / اللوغوس ومبدأ الحياة الأول ؟ أمن هنا نرى من الناس في بعض تعبيراتهم العامة من يستخدم الروح مكان الرائحة بدلالة واحدة . فهناك من يقول مثلاً : هذا روح الليمون دلالة على خلاصة عطرة . فكل رائحة بالضرورة هي روح وكيمياء جسد الأشياء والكائنات ، إنها بصمة الروح متماهية مع الجسد . فإذا كانت الروح خلاصة العطر فهل الرائحة خلاصة الروح ماداما يتبادلان الدلالة ويتماهيان؟
ولعلي أختم الحديث عن العطر والرائحة وخلاصة الروح بالتذكير بأصل المسك ، فهو ـ كما يقول الخبراء ـ دم مصفى في حالة خاصة من دم الغزال ؛ إذ يُطرد وراء الغزال لمسافات طويلة مروّعًا ، حتى تتكور غدة صغيرة في جسده تجتمع فيها خلاصة من دمه الثائر الفائر ، فتفصد تلك الغدة ، ويُستخلص منها عطر المسك ! المسك الذي هو دم وليس بدم ، إنه شيء آخر ، هو كيمياء الخوف والركض نحو الأمان ، إنه خلاصة قلق الروح ولغة روعها إذ تتكلمه لغة الجسد . وقد استغل المتنبي قصة استخراج المسك في صورته المبهرة :
فإن تَفُق الأنامَ وأنت منهم فإنّ المسكَ بعض دم الغزال
2- اللمسة :
لغة الجسد وثيقة الصلة بالكرامات والمعجزات ، خاصة معجزات الأنبياء . وظلت متوهجة بطابع سحري في معتقدات بعض الشعوب وأساطيرهم وبعض عاداتهم وممارساتهم الشعبية .
ومن معجزات الأنبياء التي ارتبطت بلغة الجسد معجزات عيسى عليه السلام ، ففضلاً عن قصة خلقه ، فقد كان يحيي الموتى بنفثة من نفسه ، ويبرئ الأكمه والأبرص بلمسة من يده .
وقد ترددت الأسطورة اليونانية عن أن قوة تأثير ( هيجيا ) آلهة الصحة كانت باللمس ؛ فما تمس يدها مريضًا إلا شفي .
ونحن نعرف حال بعض الشيوخ في ممارستهم التطبيب بالنفث وقراءة القرآن على المرضى وكيف يعضدون ذلك بوضع اليد ضاغطة على الصدر أو على موضع الألم والمرض !
إن لمسة محب بحنان ورقة يمكنها أن تفعل فعل السحر لا في الإنسان فحسب بل أيضًا في النبات ، فقد تنبه علماء الكيمياء النباتية إلى ظاهرة قوة نمو النباتات وازدياد اخضرارها بزيادة محتوى اليخضور ( الكلوروفيل ) كلما لا مستها يد بحنان وحب واهتمام عائد لعلاقة عناية وتربية ومعاشرة لهذا النبات ([4])، حيث تسري لغة خفية بين روح النبات وروح من يعتني به .
وقد تنبه البشر لأثر اللمسة في الشفاء لا على مستوى النباتات أو كرامات البشر أو حتى شعوذاتهم وأساطيرهم ، بل انتقل ذلك إلى عقر العلم والطب . ففي السبعينات من هذا القرن راحت " ممرضة أمريكية جريئة (د.كريجر D.Krieger ) تزعم وجود مثل هذا الأثر في البشر ؛ فعدد من الأمراض تتحسن ، وتميل للانكسار ،ويتحسن الوضع النفسي فتزداد المقاومة من خلال أثر لمس اليد . وأخذت مؤسسة أمريكية الموضوع مأخذ الجد ؛ وأخضعت هذه الظاهرة للدراسات العلمية الإحصائية في مشافي نيويورك ، ووصلت إلى نتائج غير متوقعة ؛ منها : ارتفاع قيمة الدم وارتفاع موجات ألفا في المخطط الدماغي الكهربي " موجات الارتخاء . " ([5])
3- قبلة الإبراء والإحياء ([6]):
عندما كنا صغارًا نصرخ متألمين كان أهلنا يأتون إلينا فيحتضنوننا ويقبّلون مكان الجرح أو موضع الألم . ولست أنسى لحظة من اللحظات المدهشة في طفولتي حينما كانت يد حنونة تضمني إليها وشفة تقبلني بنفس عذب رقيق في موضع الألم . إن لحظة الاحتواء تلك تجعلنا نستمع من خلال القبلة([7]) إلى لغة الروح الداخلية التي يمكنها أن تمهد سريعًا للتوقف عن البكاء وتسكين الألم حينما ننشغل عن الإحساس به بهذا الأمان الجديد . كأننا لحظة الألم لا نتألم بقدر ما نخاف ، تفصلنا هوة كبيرة خوفًا من الموت والانفصال بتلوناته المختلفة فتأتي القبلة لتؤمن خوفنا بأن كل هذا طارئ وزائل وجد صغير لا يستحق خوفنا .
بالقبلة – إذًا - كانوا يقنعون الصغير المتألم الباكي أن جرحه يطيب ويشفى ؛ وأن آلامه تخف وتزول بالقبل . هذه الدفقة الوجدانية وهذا التطبيب الروحي الذي يمر عبر لغة الجسد يحمل معانيه المدهشة وربما السحرية . وهو تقليد أسري أجزم بأنه شائع عند كثير من الناس ، بل لدى عدد من شعوب العالم ، ففي مقطوعة بعنوان ( بالطبع لا ) للشاعر الأمريكي بيتر فيربك ( المولود 1916) ما يشير إلى المعتقد نفسه والممارسة ذاتها :
" إن أبهج منظر خالط نظري
هو منظر " بركة الجنة " في نورثامبتون في سميث –
بصنوبره وشلاله ومرجه المهيب –
وبعده يمتد السياج ، وبعد السياج مستشفى .
ابني ذو الربيع الثالث كان يرقبني أتأمل هذا المنظر .
عندما سمعت مرة أخرى كيف أن كل شيء يحتمل تأويلات عديدة .
فهو أيضًا له معتقداته : إنه " يعلم " كحقيقة
بأن الأذى يذهب بقبلة
لقد كانت عيناي ممتلئتين بـ " بركة الجنة " حتى إنني وافقت
مع ابني لحظة ضئيلة ضآلة السياجات التي تخبئ
مستشفى ماساتشوسيتس الأميري المكتظ
بالمجانين والمصدومين أهو الافتقار إلى قبلة
ذاك الذي أحوج ولاية ماساتشوسيتس إلى بيت كهذا ؟
بالطبع ، أو ، بعد التأمل ، نعم بلا ريب " ( من مجموعة " احترق القناع " 1950م ) ([8]).
ويقول كذلك الشاعر الإنجليزي أودن في إحدى قصائده مشيرًا إلى هذا المعتقد مازجًا قبلة الشفاء وقبلة الكلمات :
" الحب هو الكلمة
قبلة جريئة واحدة تشفي
ملايين المرضى ." ([9])
وليس هذا من باب تهويمات الشعراء وخيالاتهم وجموح عاطفتهم ، بل هو شائع في أوساط الناس ، فقد تردد هذا المعنى في عدد من الأفلام الأجنبية وهي بالضرورة تحيل إلى واقع ومسلك يومي في حياة الناس مما يؤكد شيوع الاعتقاد بأثر القبلة في تخفيف آلام الجسد والروح معًا .
هذا التقليد الرقيق ( القبلة موضع الجرح أو الألم ) بما فيه من فاعلية روحية سحرية يستند إلى طبيعة العلاقة الحميمة ، فالقبلة رسول روح محب لمحبوبه ، ومن هنا يأتي المعنى الشعوري الكامن في الممارسة الطقسية لشفائية القبلة . فهل يمكن القول : إن ثمة شيء يُخلق مع نَفَس القبلة، وكأنما يستدعي المُقبِل روح الخلق الأولى ، ويتقمص دورًا سحريًا ، ويتلبس باسم من أسماء الله ـ تعالى ـ فيتوهم أو يريد أن يتوهم أنه يُشْفَى ويشفي بالقبلة ونفثة الروح في الحبيب ، وكأنما في القبلة تُستدعى كلمة الله في الإيجاد والخلق ودفع الضرر ؟!
ولعله من هنا لم نكن - ونحن صغار- حينما سمعنا وقرأنا قصة الجميلة النائمة ( بيضاء الثلج ) لم نكن مندهشين من قبلة الحياة ، بل كنا مهيئين لتصديق ذلك الأثر السحري ؛ حيث يعيد الفارس العاشق الحياة للجميلة النائمة بقبلة تخرجها من غيبوبة طويلة ؛ فللحب قواه الخالقة السحرية . فهل كانت في التقليد الأسري وعادة تقبيل موضع الألم بقايا أثرية من الحكاية الخرافية ( الجميلة النائمة ) أم أنها الحكاية نفسها تطورت ونمت من أصل مشابه ؟
إن في الإيمان بقوة الحب السحرية ممثلة في القبلة التي تعكسها العادة الأسرية والقصة الخرافية التي تنجي الجميلة النائمة من التسمم والخدر والغيبوبة ما يساعدنا أيضًا على تفسير معتقد الجاهليين من أن مجرد ذكر اسم الحبيب واستدعائه لغويًا يمكن أن يشفي الخدر الذي يصيب الجسد ([10])، ويكفي لإزالة العارض وجريان الدماء في الجسد بشكل طبيعي . ويبدو أن الخدر نوع من النوم ( يلاحظ ارتباط الخدر والنوم بقصة الجميلة النائمة ) في المعتقد الشعبي حيث يعبر عندنا في العامية النجدية عن حالة خدر الرِّجل مثلاً بالقول بأن الرِّجل نامت !! ومن المهم لفت النظر إلى هذه العلاقات المشتبكة بين الغيبوبة والخدر والنوم التي كلها تنويعات على الموت والمرض أو مؤشرات لخطره ، وهي حالات تلح كلها على استدعاء فاعلية الحبيب وحضوره وحميميته ، أو على الأقل لغته أو استحضار اسمه ليُدفع الضرر وتصح الحياة.
وقد يبدو الحديث أحيانًا عن قبلة الإبراء والإحياء محفوفًا بالمبالغات في الروحانيات وأثرها ، وبالحب وأعاجيبه . وقد قرأت منذ مدة هذا الخبر ، بمناسبة عيد العشاق لعام 1996م ، عن زوجين ظلا يقبّلان بعضهما في مسابقة لأطول قبلة لمدة خمسين ساعة متواصلة ، والخبر يؤكد على ( متواصلة ) وعلى فوز الزوجين بالمسابقة([11]). وإن صح الخبر فإن القبلة هنا تجتاز حدود الجسد لتصبح غذاء الروح والجسد معًا الذي أغنى الزوجين عن الراحة والطعام ، حيث أصبحت القبلة امتداد الروح، بل تجسيرًا لروحين تتبادلان نفثة الحياة . وأظن هذا الحدث لا يمكن أن يتم أو يصدق إلا ضمن شروط حب حقيقي نادر حيث تتحول القبلة إلى محو للجسد وإثبات للروح ، وإثبات للجسد ( بحكم آلية القبلة ) ومحو الروح ثانية .. محو وإثبات حميم مثلما يحدث في محو العزائم المبللة بالماء ([12])، أولا يبلل محو القبل بماء الروح المصفى من ينابيع الجسد ، أو بماء يتبادله عاشقان في قبلة هي كالبرزخ ، لا هي جسد ولا هي روح ؟ .
إن قبلة للصغار في موضع الألم مع المناغاة والمناجاة والتمتمات كانت تكفل الشفاء أو توهم به كما أسلفنا ، ولكن شفائية القبلة يمكنها أن تمتد إلى أبعاد مجازية كتلك التي مسها ( أودن) في الاستشهاد السابق ، أعني أن الملامسة الحسية يمكنها أن تتحول إلى ملامسة لغوية . فكلمة حب رقيقة مواسية يمكنها أن تعادل القبلة ، بل هي قبلة الكلام. وهو ما يحدث في عدد من العلاقات الإنسانية ، ففيما تنمو ، أو يخيل إليها أنها تنمو ، نحو التجريدية والنضج إذا بها تعود مرة أخرى إلى تغليب اللغة على الفعل الأكثر قربًا وحميمية ، تعود ثانية إلى تفصيح المناجاة والمناغاة والتمتمة الطلسم فتفقده دهشته وسحريته ، لكنها تبدع من إفصاح اللغة ومن المجاز المكشوف عالماً فيه دفء معقلن ، وهو ما يمنح من طريق آخر العلاقة الإنسانية شيئًا من التسكين ، شيئًا من الأمان والراحة. فنحن في الطفولة نقنع بحضن حميم وقبلة عطوفة ، ولكننا حينما نكبر نحتاج( فوق الدفء الإنساني والحضن الحميم ) موئلاً لراحة العقل الذي نما . نحتاج مع حاجة الروح حاجة العقل ؛ لذلك كلما كبرنا وكلما اشتد فزعنا أمام تناقضات الوجود ، واشتد ألمنا من قسوتها نفصّح التمتمة الطلسم ، والشعر يفعل ذلك كثيراً. وهذا التحول بقدر ما هو ضروري يبدو منطقيًا كذلك إذ نضاعف مع القبلة الجسدية القبلة اللغوية في محاورة عقلية تليق بنا وبالوجود.
4- النفث والماء والماوراء :
إن تلك العادة الرقيقة ، المشار إليها فيما سلف ، المكتنزة بالدلالات التي تعكسها الممارسة الشعبية قد تتجاوز مجرد القُبلة والحضن الحنون ، وتأخذ جانبًا طقوسيًا عند بعض الناس فترتبط مع المناغاة بشيء من التمتمات مع نفث النفس ، وتتحول هذه الطقوسية لمناغاة الصغير وملاطفته إلى مجرد نفث في مواقف أخطر وأكثر انتشارًا عند الناس ، أعني في مواقف مداواة الكبار من مرض أو فزع أو مس أو جنون ، إلى غير ذلك مما يعتقد العامة أن النفث مع القراءة تشفيه . وهي ممارسات طقسية تستند إلى معتقد ثابت عند من يمارسون التطبب والتطبيب بهذا اللون من الاستشفاء . ويلاحظ أن عملية الاستشفاء هذه تعتمد على مراجعات ودورات ، وتتم أصلاً تحت مصطلح (القراية أو القرآن) في الأوساط الشعبية سواء عند الشيوخ والقراء أم المشعوذين وغيرهم .
ونلاحظ أن كلمة قرآن أو قراية تأتي من القراءة ، وهي كذلك تقرن بين القراءة والتلفظ اللغوي المبين أو المبهم المطلسم تقرن ذلك بالنفث أو النفخ حيث تتعاضد لغة الجسد وجسد اللغة معًا .
وقد يكتفي المريض بأن ينفث عليه الشيخ المعالج ويقرأ عليه ما تيسر من القرآن أو المعوذات ، أو حتى بعض المطلسمات والحروف . وبعضهم لا يكتفي بذلك بل يخرج من عند المعالج يحمل الماء ، وقد نُفث فيه وقرئ عليه أيضًا ، ليشرب منه المريض حتى موعد الزيارة المقبلة، فلا تنقطع صلته بجسد اللغة المختلط بالماء !.
ويمكن بدلاً من حمل الماء حمل أقراص صغيرة من العجين المجفف المعجون أصلاً بماء منفوث فيه ومقروء عليه كذلك لينقع فيما بعد ويشرب . أو يمكن حمل العزائم ، التي تسمى في بعض مناطق الجزيرة والخليج ( المحو) وهي ورق مكتوب عليه بماء الزعفران بعض الحروف والكتابات المبهمة ، والتي يعتقد بعض الناس بحرمة محاولة قراءتها ، ويعتقدون ببطلان الفائدة والطاقة الشافية في حال قراءتها ، حيث يغمس الورق ـ عند الحاجة إليه ـ دون قراءته في ماء الورد أو بماء عادي وكلها عمليات تعمد إلى تذويب اللغة ومحوها لتتغلغل ماديًا وحسيًا ، وتمتزج داخل جسد المريض ، ولا بد أن تتم عبر وسيط الماء . وسأتوقف لاحقًا عند مسألة وسيط الماء هذا وزهرة الزعفران .
ويلاحظ هنا أن التحذير من قراءة المحو أو تحريمه ينطلق من المنطلق نفسه الذي يتحرك من خلاله السحر والسحرة ، فهنا تقاطع وتداخل واضح إذ يرى السحرة أن السحر علم مخصوص وهب القدرة عليه بشر محدودون ، وأنه علم تقوم قدرته على التأثير الخفي من جهة وعلى الإيحاء القوي ، ذلك التأثير الخفي الذي يجب أن يحتفظ بسره ، ولو كُشفت أسراره وفُكت آلياته وطرق عمله لبطل !.
إن هذه الممارسة الطقسية للمعالجات لا تستمد قوتها من الإيحاء فقط ، أو من الدلالة المباشرة لهذه الممارسة الترميزية ، وإنما تستمد القوة والفاعلية من السلطة التي يتحرك من خلالها المتكلم أو الشيخ القارئ النافث المعالج بالنفث والكلام وبالقراءة ، تلك السلطة التي تأتيه من اقتناع المريض وتسليمه ، والمريض يستمد بدوره هذا الاقتناع من سلطة خطاب أكبر هو الخطاب الاجتماعي المهيمن والخطاب الإيديولوجي . إن هذه الممارسة الطقسية بكل أطرافها وبكل ملابساتها تستمد قوتها وهيمنتها على الوعي واللاوعي الشعبي من الصلة التي تعقدها بالغيب والماورائيات . وتعتمد في معتقدها على تيمة شفاء تقرن لغة الجسد ( النفث وبث النفس ) بجسد اللغة ( القراءة الجافة أو القراءة من الخارج على المريض وعلى الماء ، أو الكلام المكتوب في العزائم والمحو ، المكتوب بماء الزعفران والمذوب بماء الورد ) حيث تلتبس اللغتان وتمتزجان ، وتلتحم النفثة بالكلمة التي يعتقد أنها تدفع الضرر وتحمي وتشفي وتبعث ! .
ألسنا هنا أمام كلمة الخلق ، أمام اللوغوس بشكل أو بآخر ، ولست أعني باللوغوس هنا العقل والفكر وإنما الارتداد إلى المبدأ والأصل . وقد كنت أشرت في أثناء الحديث عن قبلة الإحياء والإبراء إلى العلاقة بالنفث وتقمص الدور الإلهي في الخلق ، حتى إنه يمكن النظر إلى تيمة الإحياء في ( الجميلة النائمة ) وردها إلى المبدأ الذكوري ، (المبدأ الأصل كما في الرؤية البطريركية الأبوية) حيث يرد العاشق الحياة للجميلة النائمة بروحه وقبلته وهو شيء مشابه ؛ من بعض أطرافه ، لقصة الخلق الأولى ، حيث تخلق حواء من آدم ، ولكن حينما كان هو نائمًا هذه المرة ! وهذا الموضوع يطول الحديث فيه ؛ وهو موضوع دراسة مستقلة عن المرجعيات الدينية والأسطورية في قصة الجميلة النائمة آمل أن أنجزها قريبًا. لكن ما أردت الإشارة إليه في هذا الاستطراد هو هذا الامتداد في أصل هذه الممارسة في النفث والقراءة والنفس إلى جذور كلمة الخلق والنفخ في الكائنات ، وهي علاقة غائرة كما يرى .
ولست بحاجة لمزيد إضافات عن ارتباط النفث وبث النفس بالمعتقدات المقدسة ، فهي،كما قلت ،كلمة الله في الخلق والإيجاد ، وهي النفخة الإلهية التي تبث الحياة وتبعثها في الموات . إنها النفخة التي ترتبط بكلمة الكينونة وبالأمر الإلهي : كن ، فيكون . وربما من هنا من هذا المنطلق ، منطلق السعي وراء نعمة العافية ونعمة المعرفة ونعمة القيام بالتكليف ، كان البحث عن انبثاث النفس الرحماني في الوجود ، ومحاولة تعقبه وامتلاكه وامتلاك تأثيره ، وهو ما اهتم به المتصوفة ، وهو ما يفسر انشغال بعضهم بأمثال هذه الممارسات وما أُثر عنهم من كرامات ، وما تركوه من مؤلفات في الروحانيات والعلم الباطني .وعن الانبثاث والتعقب للنفث والنفس الرحماني يقول ابن عربي : " النفس الرحماني هو فيضان وجود الممكنات التي إذا بقيت في العدم على حال ثبوت أعيانها بالقوة كانت كرب الرحمن إذا وصف نفسه بالنفس وجب أن ينسب إليه جميع ما يستلزمه النفس من التنفيس وقبول صور الحروف والكلمات ، وهي هاهنا الكلمات الكونية والأسمائية ، فإن الوجود إنما يفيض بمقتضيات الأسماء الإلهية ومقتضيات قوابلها " ([13])
جسد اللغة:
أشرت وأنا أتحدث عن النفثة في القسم الخاص بلغة الجسد إلى طريقة من طرائق الاستشفاء ( المحو) أو العزائم التي تذوب بالماء . ومن الطبيعي ، كما أشرت هناك ، أن تلتحم النفثة والكلمة فتقترن لغة الجسد بجسد اللغة لالتباس لغة الجسد ( النفث وبث النفس ) بجسد اللغة ( من المعوذات والآيات القرآنية ، والحروف المزعفرة والطلسمات ) ، وهذا الالتحام بين اللغتين يجعل من العسير الفصل إجرائيًا ومنهجيًا بينهما . ولكن سأتوقف بدءًا عند جسد اللغة ، هذا الذي يذوب ويمحى ، سأقف عند زهرة الماء .
1- زهرة الماء :
قلت إن هذه الممارسة الطقسية للمعالجة والاستشفاء التي تعمد إلى محو جسد اللغة وتذويبه تستمد قوتها وفاعلية تأثيرها من الصلة التي تعقدها بالغيب والماورائيات ، وانطلاقًا من اعتقاد عام بالكلمة التي تشفي وتخلق !! ولكن أليس في الماء المزعفر شيء آخر غير اللغة العلوية أو الطلسمات الغامضة ؟ أويمكن أن تكون الزهرة الذهبية بخطوطها المقوسة المعقوفة على الورق أفعى تتلوى ؟ وما علاقة الأشكال المرسومة بماء الزعفران الذهبي اللون على ورق المحو ، تلك الخطوط الملتوية والحرف المهملة بلا نقاط أو نبرات ، وتلك الدوائر المكتملة أو التي لم تكتمل - ما علاقتها بأشكالها الأفعوانية المختلفة بزهرة ( زفس ) الذهبية الأسطورية المرتبطة بالثعابين ؟ تلك التي طالما عُزي إليها معرفة النباتات التي تسترجع الحياة ، والتي ظلت رمزًا للأدوية والصيدلية وضروب الاستطباب ؟
قد يبدو أن لا علاقة تستدعي هذه الأسئلة ، ولعلها فعلاً علاقة بعيدة ، لكن لا يحسن هنا إهمالها . إنها تتعلق بأسطورة بعث ( طيلون ) حيث تجري القصة على النحو التالي : بينما " كان ذات يوم يمشي على ضفاف نهر هرموس لدغه ثعبان فقضى على حياته . فلجأت أخته ( مويره ) إلى جن يدعى ( دماس ) فهرع هذا إلى الثعبان وقتله ، غير أن زوج الثعبان اقتطعت نبتةً هي زهرة ( زفس ) من أحد الأحراش ، وحملتها في فمها ووضعتها على شفتي الثعبان الميت فعاد إلى الحياة في الحال . واسترشدت ( مويرة ) بذلك ، وأعادت أخاها ( طيلون ) إلى الحياة بلمس شفتيه بنفس تلك النبتة "([14]).
ويمضي جيمس فريزر الذي أورد القصة السابقة في غصنه الذهبي قائلاً : " وهناك من يعتقد أن قصة بعثه كانت تمثل في احتفال يرمز إلى عودة الحياة إلى النبات في الربيع . مهما يكن من أمر فإن مهرجانًا يدعى ( عيد الزهرة الذهبية ) كان يقام تمجيدًا لبرسيفوني في سارديس ، وربما كان ذلك في أحد أشهر الربيع ، ومن المحتمل جدًًا أنهم كان يمثلون بعث البطل وبعث الآلهة معًا حينئذ . والزهرة الذهبية في هذا المهرجان تكون زهرة زفس المذكورة في الأسطورة ن ولعلها زهرة الزعفران الرائعة الصفرة ، التي تسبغها الطبيعة بسخاء على بعض الأماكن في الشرق " ([15]) .
فهل ثمة خط يجمع بين هذه الأسطورة وهذا المعتقد بزهرة الزعفران ؟ ربما ! لكن الأمر اليقيني الواضح المشترك هو هذا الاتكاء على تيمة الشفاء في بعث العافية والحياة في الجسد ، والاعتقاد به عن طريق هذه الزهرة . وإن كانت الزهرة في حال العزائم والمحو ليست سوى وسيط لكتابة جسد اللغة ليذوب فيما بعد ويشرب ، حيث تلتبس اللغتان لغة الجسد وجسد اللغة ، وحيث تلتحم النفثة بالكلمة التي يعتقد أنها تدفع الضرر وتحمي وتحيي وتبعث .
2- سقيا الكلام ، محو وإثبات :
إن تيمة الاستشفاء بالنفث مع القراءة والنفخ على الماء أو عن طريق العزائم ( المحو ) ترتبط بالماء ، فالزعفران يذوّب في الماء ثم يكتب بمائه على ورق لتذوّب بدورها تلك الكتابة عند الاستعمال بماء الورد أو ماء عادي ، فلابد من وسيط مائي لتذويب جسد اللغة ، ليشرب الكلام ممحوًا ، ويتغلغل في جسد المريض عبر الماء اعتقادًا بالطاقة المذابة فيه وبروحانيته السحرية . ترى أي شيء تمحوه وتثبته هذه الممارسة ؟ هذه الطقسية عبر الطلسمات وعبر الكتابات المزعفرة ، المحرمة قراءتها ، والتي تكتب بطريقة لا يمكن إرجاعها لنظام محدد ومفهوم ([16])، أتفزع إلى ذلك لتسيطر على فوضى الجسد ( والمرض : فوضى في نظام الجسد ) بفوضى اللغة ومحو المعنى ؟ أترمز من خلال المحو والتذويب إلى تذويب الألم والمرض واضمحلاله و إثبات أثر الكلمة المرتبطة بالغيب ، الكلمة المرطبة بالماء ، الكلمة التي تبعث وتخلق وتشفي ؟ فما قصة الكلمة المرطبة بالماء ، ما قصة هذا الوسيط في هذه الممارسة ؟
إن هذا الارتباط بالماء يوضح مدى علاقة تيمة الاستشفاء هذه بتيمة الماء في رمزيته الأسطورية والدينية ؛ فالماء هو الشكل الأولي للتجلي ، وهو مصدر الحياة ورمز لخصب والحياة والتجدد والمعرفة والخلود عند كثير من شعوب العالم ودياناته . بل إن مفهوم المياه الأولية ومحيط الأصول والبدء مفهوم شبه عالمي ([17]) ، فللماء " صلة قوية ببدء الحياة على وجه الأرض في التراث الإسلامي ، فالعرش والماء كانا مخلوقين قبل خلق السموات والأرض ... وفي شرحه لفصوص الحكم [ لابن عربي ] ، يطابق جامي بين الماء الذي يعلوه العرش الإلهي ونفس الله الرحيم ... ويمعن جلال الدين الرومي في اتجاهه الميتافيزيقي فيرمز إلى البناء الإلهي للكون بمحيط ماؤه هو الجوهر الإلهي وأمواجه هي المخلوقات " ([18]) .
وقد ذكر الله الماء كثيرًا في محكم تنزيله مشيرًا إلى موقعه في أصل الخلق ومبدأ الحياة . يقول الله عز وجل : ( أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقًا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون ) ([19]) . وقال الله تعالى ( هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ) .([20])
و يرتبط الماء في معظم الديانات بالاغتسالات الشعائرية ، وبطقوس الطهارة والتطهر ، بل إن الميت في الديانة الإسلامية لا بد أن يمر إلى القبر بطقس عبور يمر عبر الماء . وقديمًا قدس بعض العرب الجاهليين بعض الآبار والعيون ، وهي نظرة تعكس إلى حد كبير معتقدًا غامضًا لدى الناس بالاستشفاء بالماء أو استجلاب القوة والمنفعة والخير بالطاقة الشافية التي يملكها الماء المبارك .
ولعله من هنا ، من هذه العلائق الغائرة حول رمز الماء وعلاقته بالخلق ومبدأ الحياة والتبرك به ، يأتي وسيط الماء ضرورًة لازمة للعزائم والمحو ورقى الماء كإحدى الوسائل الطقسية التي تمارس طلبًا للاستشفاء .
ولعلي أختم هذا الجزء عن زهرة الماء وسقيا الكلام بالإشارة إلى علاقة الماء والرطوبة بالكلمة الخالقة في إحدى الأساطير اللافتة للنظر ؛ فرمز " الماء باعتباره قوة مخصبة يذهب أبعد من ذلك أيضًا في فكر ( الدوغون ) وجيرانهم الـ بامباراس Bambaras ؛ لأن الماء أو البذار الإلهي هو النور والكلام والكلمة الخالقة ، ويعتبر اللولب النحاسي رمزه الأساسي .غير أن الماء والكلام لا يصبحان فعلاً وتجليًا ، ولا ينتجان خلق العالم إلا بشكل كلام رطب يقابله نصف توأم باق خارج دورة الحياة المتجلية ، وهو ما يسميه الدوغون والبامباراس ماءً جافًا وكلامًا جافًا ، ويعبر الماء الجاف والكلام الجاف عن الفكرة أو الإمكانية الضمنية على المستوى الإلهي وعلى المستوى الإنساني . فكل ماء كان جافًا قبل أن تتشكل البيضة الكونية التي ولد في داخلها مبدأ الرطوبة ، وهذا المبدأ هو قاعدة خلق العالم لكن الإله الأوراني الأعلى ( أمّا Amma) المنحدر من أورانوس حين خلق قرينه ( نموNommo ) إله الماء الرطب مدبرًا ومبدأً للحياة المتجلية احتفظ الأول لديه في السموات العليا وخارج الحدود التي منحها للكون بنصف هذه المياه الأولى . وهذا النصف هو المياه التي بقيت جافة . وكذلك يقال للفكرة التي لا يعبر عنها فكرة جافة ، فليس لها إلا قيمة ضمنية ولا يمكنها أن تلد . وهي تمثل في العالم الإنساني الصغير نسخة مطابقة لفكرة الأولية أو الكلام الأول ، الذي سرقه يورغو Yurugu)) بعبقريته من ( أما ) قبل ظهور الناس الحاليين . ويرى بعض الباحثين أن هذا الكلام الأولي وغير المتميز والخالي من وعي الذات يقابل اللاوعي . إنه كلام الحلم ، ذلك الكلام الذي لا يستطيع البشر التحكم فيه . إن ابن آوى أو الثعلب الشاحـب ( وهو صورة انمساخ اليورغو ) بما أنه قد سرق الكلام الأول فهو يملك مفتاح اللاوعي والغيب ، ويملك تبعًا لذلك مفتاح المستقبل ، وما هذا المستقبل سوى عنصر من عناصر الغيب . ولذا أقيم أهم مذاهب الكهانة عند الدوغون على أساس استجواب هذا الحيوان " ([21]) .
وقد أوردت الأسطورة السالفة ، أولاً لكون رمز الماء فيها يمثل باللولب النحاسي الذي له شبه واضح من جهة اللون ومن جهة شكل اللولب الذي يشبه شكل الكلام المكتوب في الكتابات المزعفرة في التعاويذ والطلسمات . وثانيًا للارتباط بالناحية السحرية والكهانة وعقد الصلة بالغيب . وثالثًا لأنه في جزء من التأويل لمنشأ هذه الأسطورة ومعادلتها في حياة البشر حيث يعادل الكلام الأولي وغير المتميز والخالي من وعي الذات باللاوعي ، وهو ما يمكن النظر فيه في ضوء ما أشرت إليه من تقنية المحو والتذويب ، وتمييع المعنى ونظام اللغة ، وخاصة في الطلسمات، التي تبدو كشيء لا يمت بصلة لإدراكات الوعي مثلما أنها شيء لا يمكن التحكم فيه في سياقات الوعي واللاوعي معًا ، خاصة حينما يسري مع اعتقاد المريض الماء في جسده حاملاً الشفاء بسحره وأسراره وروحانيته ، أو حتى حينما تحمل الطلسمات والتعاويذ قدراتها في التغيير والتبديل والعبور نحو الغيب والمستقبل ، وكأنما تبدو هنا مفاتيح اللاوعي ومفاتيح المستقبل والممكن مذابة في الماء المزعفر وبذلك يتحول الماء المزعفر سقيا الكلام إلى كهانه وسحر سائلين !
وكما أشرت في مقدمة هذه الدراسة ليس الغرض من معارضة هذه التيمة أو بعض أجزائها وتفصيلاتها ببعض الأساطير هو المقارنة أو إثبات صلات ما ، فذلك ليس من شأن هذا البحث وأهدافه ، وإنما المراد لفت النظر إلى مواطن شبه قد تبدو قوية أحيانًًا أو باهته أحيانًا أخرى ، ولكن ، لأهمية ألإشارة إلى أن الفكر البشري في مختلف بقع الأرض ومع اختلاف الأزمان يتشابه في لحظات مرضه وضعفه ، ويتقاطع في وسائل صلاته التي يلجأ فيه للشعوذات وللكهان والسحرة وغيرهم .كما أن تلك التشابهات سواء أكانت في أصول التيمة أم في بعض تشكلاتها كما في زهرة الزعفران أم من حيث الشكل كما في اللولب النحاسي – ليست سوى رموز بصرية شكلية ، ومثل تلك الرموز البصرية والرسومات أو حتى الأيقونات يمكنها التجول والانتقال عبر الشعوب بمعابر قد يستحيل حتى على المقارني أن يضع يده عليها ويحددها.
3- الكلمة / الشفاء / والتأويل :
مرّ قبل قليل في سقيا الكلام ، كيف يُعتقد بالكلام المطلسم ، أو الكلام المكتوب المذاب ، في الماء من الآيات القرآنية وغيرها ، وبأثرها في الاستشفاء . وأشرت إلى أن الاعتقاد بقوة التأثير وفاعليته وسحريته تأتي من الصلة التي يعقدها بالكلام الإلهي المقدس وبالغيب عمومًا والماورائيات . ولكن إذا كان هذا الاعتقاد بأثر بالكلام يرتبط بهذه المرجعية الدينية بالمقدس ، ففي بعض اعتقادات الناس بالكلمة التي تخلق وتشفي ما هو أعم وأوسع دائرة من مجرد التماس الشفاء عن طريق استغلال الكلام المقدس ذاته ؛ فقديمًا شاع الاعتقاد بأثر الكلمة وطاقتها مطلقًا عند الجاهليين وكانوا يسمون الملدوغ سليمًا , والبيداء مفازة درءًًا للخوف من المرض والموت ، وتيمنًا بالشفاء وأملاً بالحياة .
وهذا الاعتقاد منتشر وظاهر حتى في التعبيرات العامية المتداولة إلى يومنا هذا ، ويظهر كذلك في الأمثال الشعبية ، حتى إنه ليصل الاعتقاد بإمكانية العدوى من مجرد التلفظ بالكلام عند ذكر الأمراض ، أو عند ذكر أسماء الأشخاص المبتلين إذا تشابهت الأسماء ؛ حيث يقولون " الاسم سالم " إذا ذكر اسم شخص فيه عاهة أو مرض وتوافق اسمه مع اسم شخص ما موجود في المكان نفسه . ثم راحت العبارة تجرى في الاستعمال مجرى التأدب والتهذيب والدعاء ، ولكنها لم تستطع إخفاء جذرها الضـارب في هذا المعتقد .
وشاعت ، ومازالت تشيع بين الناس ، المعوذات وذكر اسم الله قبل ذكر الجن وأسماء الأمراض . وكأن مجرد ذكر الاسم يعني الحضور مباشرة . وهذا يعكس بقوة الاعتقاد بفاعلية الكلمة وطاقتها والقوة الكامنة فيها .
وقد كان في معتقد الجاهليين ومسلكهم ما يشير إلى عقلية تؤمن بخطر الكلمة وأثرها كما أسلفت ، حتى كان الواحد منهم إذا خدرت رجله أو أحد أعضاء جسمه ذكر اسم من يحب فيذهب الخدر . وقد تردد هذا المعنى في سلوكياتهم التي أرخت وحفظت فيها وصلنا عنهم من أخبار ومعتقدات ، كما عكستها أيضًا أشعارهم .
وقد تواتر الشعراء من بعد الجاهليين هذا المعنى حيث قال جميل :
وأنت لعيني قرة حين نلتقي وذكرك يشفيني إذا خدرت رجلي
وقالت امرأة :
إذا خدرت رجلي دعوت : ابن مصعب فإن قلت :عبد الله : أجلى فتورها
وقال الوليد بن يزيد :
أثيبي هائمًا كلفًا معنّى إذا خدرت له رجل دعاك
وقد أورد الألوسي صاحب " بلوغ الأرب " في مطلع حديثه عن هذا المعتقد عند عرب الجاهلية " أن عبد الله بن عمر خدرت رجله فقيل له : ادع أحب الناس إليك ، فقال : يا رسول الله " ([22]) . وعلّق على هذا الشارح محمد الأثري قائلاً " قد استدل الحشيون وعباد القبور بهذا الكلام على جواز الاستغاثة بأصحاب القبور عند الشدائد ونداء غير الله -سبحان وتعالى – وهو كما ترى استدلال غريب يدل على جهل فيهم عظيم . والجواب عنه أن هذا ليس نداء بما لا يقدر عليه إلا الله تعالى ، غاية ما فيه ذكر المحبوب لا طلب شيء منه ولا استغاثته ، وإلا لزم أن كل من ذكر محبوبه فقد استغاث به ، وبطلانه ظاهر . وقد علل بعض العلماء زوال الخدر بذكر المحبوب بأنه بمسرته وتوجه حواسه نحوه تنتفش حرارته الغريزية فيذهب الخدر .وقال إن فعل الجاهلية وحديث ابن عمر يؤيدان صحة ما جرّبه الناس في ذلك "([23]).
وفي الاعتقاد بتفسير الأحلام ووقوعها حسبما تفسر ما يعكس هذه الرؤية حول قوة الكلمة وأثرها . فالأحلام – كما جاء في المأثور النبوي – معلقة بجناحي طائر وهي كما تفسر تقع . فالتنبؤات وفك شارات الحلم وشيفراته ورموزه نوع من التأويل الذي ليس سوى لغة تشرح لغة الجسد ( الحلم ) ، وما أن تحط مدلولات هذه اللغة الشارحة على جناح الطائر حتى يهبط ويقع ، بقدرة هذه اللغة وطاقاتها الفاعلة التي تهبط به من الإمكان إلى التحقق ، من الغيب والماوراء والميتافيزيقا إلى فيزيقا الزمان والمكان والحدث .
بل إن الحلم نفسه ، وهو لغة النفس واللاوعي ، لغة الجسد المفعمة بالكلام والصور والأخيلة ، إذا كان مرعبًا أو سيئًا يُطلب من الشخص إذا تنبه إثره أن ينفث على نفسه وجانبه الأيسر ، وينقلب لينام في جهة أخرى معاكسة . وهذه ممارسات تشير إلى محاولة تفادي لغة الحلم وحرف مسار تحققها بالنفث وبالنوم على جهة معاكسة مع الذكر والمعوذات اتقاءً لشر نبوءة قد يهجس بها الحالم وتمتلئ بها نفسه .
وسأختم هذا الجزء بهذه القصة القصيرة التي ترويها الجدات والعجائز تحت باب الحمق وطرائفه ، ولكنها تعكس ما استقر في الوجدان الشعبي واللاوعي الجمعي مدى ارتباط الكينونة والوجود البشري باللغة حتى إنهما يتماهيان ، بل لا يتماهيان فحسب ، وإنما تتحول اللغة إلى معيار ومقياس الحياة ذاتها .وتقول القصة إن أحمقين كانا يسيران في طريق فوجدا رجلاً ميتًا فارتعبا وخشيا أن يكون هذا الميت أحدهما ، ولم تكن ثمة وسيلة للتأكد من ذلك ونفي هذا الاحتمال المرعب حسب اعتقادهما إلا عن طريق اللغة ، حيث تفتق ذهنهما عن هذه الحيلة لاكتشاف حقيقة الأمر ؛ فقد قررا أن يتفرقا ، ويذهب كل واحد إلى رأس جبل مجاور فينادي كل منهما على صاحبه فإن أجاب كل واحد نداء صاحبه فقد ثبتت نجاته من احتمال أن يكون الميت !!
ولا يمكن أن نطفّف من رؤية كهذه حتى لو سيقت في مجال التندر بالحمق وأهله ، حيث تمسي اللغة لا مجرد وسيلة شفاء ، وإنما وسيلة أمان ضد الأعنف والأقوى من المرض ، ضد الموت ، وتمسي أداة يقين ومسبار وعي يحقق الحياة ويضمن استمراريتها .
4- الحروف وإثرها في المعالجات :
إن الاستشفاء يستند إلى أثر عبارات وجمل من الكلام المقدس والتعويذات ، كما مر قبل قليل في " الكلمة الشفاء والتأويل " الاستناد إلى مبدأ يتعلق بأثر الكلمة بمجرد ذكرها ، وهنا أتوقف عند معتقد آخر ينظر إلى الحرف مستقلاً ، فثمة معتقد يستند إلى أثر الحروف وطبائعها وأسرارها وخاصياتها وآثارها العلاجية .
ويبدو أن الاهتمام بأسرار الحروف تزايد في بيئة المفسرين المتصوفة منهم على وجه الخصوص ، حيث شغلت الحروف في مطالع بعض السور عددًا منهم .وقد اعتنى بها ابن عربي عناية كبيرة ، وشُغل بالنظر فيها من زوايا كثيرة ، أهمها زاوية التأمل الصوفي بوصفها ( أي الحروف ) عالمًا وأمة من خلق الله مكلّفة مثل بقية العوالم ، ولها أسرارها وخواصها . فتراه في كتابه (الفتوحات المكية) يخصص أجزاء للحروف ومراتبها وطبائعها وأسرارها ، حيث يوزعها في زمر ، ويخص الحضرة الإلهية والإنسانية والجنية والملائكية بحروف بعينها من " عالم الحروف " كما أسماه ، وينزلها مراتب وأقدارًا . وتراه في فصل آخر يوازي أفلاك العناصر بموازاة أفلاك للحروف ... إلخ من الفصول المتعلقة بأسرار الحروف وأقدارها .
وفي الفتوحات المكية ، أشار إلى انشغاله بتأليف كتاب سماه : " المبادئ والغايات فيما تحوي عليه حروف المعجم من العجائب والآيات " يقول فيه إنه يتحدث ضمن ما يتحدث عن " المناسبة الجامعة بين هذه الحروف وبين الحضرة الآلهية) " ([24] .
وهو يتحرك في رؤيته لها بأنها أمة من خلق الله مخاطبون ومكلفون .بل هو يتحدث عنها بالضمير الذي لا نستخدمه عادة إلا للحي العاقل في حال الجمع . يقول " - اعلم وفقنا الله وإياكم- أن الحروف أمة من الأمم ، مخاطبون ومكلفون؛ وفيهم رسل من جنسهم ولهم أسماء من حيث هم ولا يعرف هذا إلا أهل الكشف من طريقنا . وعالم الحروف أفصح العالم لسانًا وأوضحه بيانًا .وهم على أقسام كأقسام العالم المعروف في العُرف . فمنهم عالم الجبروت ... وهو الهاء والهمزة، ومنه العالم الأعلى وهو عالم الملكوت وهو الحاء والخاء والعين والغين .ومنهم العالم الوسط ... فهؤلاء عوالم الحروف ، ولكل عالم رسول من جنسهم ولهم شريعة تُعبّدوا بها .ولهم لطائف وكثائف .وعليهم من الخطاب الأمر : ليس عندهم نهي .وفيهم عامة وخاصة وخاصة الخاصة وصفا خلاصة خاصة الخاصة! " ([25]).
وإذا كان ابن عربي قد جهد في الشروح والتعليلات لخصائص الحروف وأرقامها وعلائقها بالأفلاك والعناصر الأربعة ، وتحدث عن روحانياتها وأسرارها انطلاقًا من اهتماماته الصوفية وانشغاله بعالم الغيب والشهادة وكشوفاتهما ، فنحن نرى بعد ذلك كيف امتدت هذه المسائل والمباحث المتعلقة بالحروف واتسعت فيمن بعده ، وصرفت لاستغلال الأسرار والخواص في باب المعالجات ومن ثم في أبواب السحر والشعوذات والطلسمات .
وما زال من الناس في وقتنا الحالي على اختلاف درجات تعليمهم وفهمهم ووعيهم وثقافتهم من يعتقد بأثرها ويلجأ إليها ، عند الحاجة فيما يسمونه الأعمال والطلسمات ، فيلجأ أولئك إلى من يحضرون الأرواح والجن ليعملوا أعمال السحر ، تلك التي يستند في عملها المشعوذون والسحرة على أرقام وحسابات يؤكدون أنها علم قائم بذاته ، وهبوا إيّاه ويحرصون على سريته وإلا بطل . وهم يعمدون – كما ترى في بعض الكتب التي نقلت شيئًا من أساليب الرقى والتعاويذ والأعمال - إلى تركيب حروف معينة مع بعضها وتبدو مطلسمة بلا معنى ، لكنهم يعادلون الحروف بقيمها العددية ،فيثلثون ويربعون ..إلخ حسب الحاجة ونوع الطلب ، وتحسب الحسابات الدقيقة ، ويتُحين لها زمان ومكان معلوم ومحسوب ، ويتحرون فيه الطوالع والأبراج ، ويستعينون بالخدام والأعوان ( الملائكة والجن ) – كما يزعمون - ليحققوا الشفاء وأنواع المطالب الأخرى !
وقد ألفت في ذلك منذ وقت مبكر مؤلفات في هذه الحروف وخصائصها وفي الأعمال والشعوذات ، وذكرها معتقدًا بها علماء أجلاء . وقد توقفت طويلاً وأنا أقرأ مقدمة لسان العرب لابن منظور حيث بدأ معجمه الشهير بالحديث عن ترتيب الحروف ومخارجها ثم أعقب ذلك بكلام مثير عن خصائص الحروف ، وعن أهل العلم باستخدامها للعلاج والطلسمات .
وسأورد هذا النص لابن منظور ، ففيه من الإشارات المفيدة لهذا الجزء من الدراسة ما يبرر الوقوف عنده على طوله .يقول في باب ألقاب الحروف وطبائعها وخواصها :
"وأما خواصها فإن لها أعمالاً عظيمة تتعلق بأبواب جليلة من أنواع المعالجات ، وأوضاع الطلسمات . ولها نفع شريف بطبائعها ، ولها خصوصية بالأفلاك المقدسة وملائمة لها ، ومنافع لا يحصيها من يصفها . ليس هذا موضع ذكرها،لكنا لا بد أن نلوح بشيء من ذلك ، ننبه على مقدار نعم الله تعالى على من كشف له سرها ، وعلمه علمها ،وأباح له التصرف بها . وهو أن منها ما هو حار يابس طبع النار ، وهو : الألف والهاء والطاء والميم والفاء والشين والذال ، وله خصوصية بالمثلثة النارية ؛ ومنها ما هو بارد يابس طبع التراب ، وهو : الباء والواو والياء والنون والصاد والتاء والضاد ،وله خصوصية بالمثلثة الترابية ؛ ومنها ما هو حار رطب طبع الهواء ، وهو : الجيم والزاي والكاف والسين والقاف والثاء والظاء ، وله خصوصية بالمثلثة الهوائية ؛ ومنها ما هو بادر رطب طبع الماء هو " الدال والحاء واللام والعين والراء والخاء والغين ، وله خصوصية بالمثلثة المائية .
ولهذه الحروف في طبائعها مراتب ودرجات دقائق وثوان وثوالث وروابع وخوامس ويوزن بها الكلام . ويعرف العمل به علماؤه : ولولا خوف الإطالة ، وانتقاد ذوي الجهالة ، وبعد أكثر الناس عن تأمل دقائق صنع الله وحكمته ، لذكرت هنا أسرارًا من أفعال الكواكب المقدسة ، إذا مازجتها الحروف تخرق عقول من لا اهتدى إليها ، ولا هجم به تنقيبه وبحثه عليها . ولا انتقاد عليّ في قول ذوي الجهالة ، فإن الزمخشري - رحمه الله تعالى - قال في تفسير قوله عز وجل ( وجعلنا السماء سقفًا محفوظًا ، وهم عن آياتها معرضون ) ، قال : عن آياتها أي عما وضع الله فيها من الأدلة والعبر ، كالشمس والقمر ،وسائر النيرات ، ومسايرها وطلوعها وغروبها على الحساب القويم ، والترتيب العجيب ، الدال على الحكمة البالغة والقدرة الباهرة .
وذكر الشيخ أبو العباس أحمد البوني - رحمه الله - : منازل القمر ثمانية وعشرون منها أربعة عشر فوق الأرض ؛ ومنها أربعة عشر تحت الأرض . قال : وكذلك الحروف : منها أربعة عشر مهملة بغير نقط ، وأربعة عشر معجمة بنقط ، فما هو منها غير منقوط فهو أشبه بمنازل السعود وما هو منها منقوط فهو النحوس والممتزجات ، وما كان منها له نقطة واحد ، فهو أقرب إلى السعود ؛ وما هو بنقطتين ، فهو متوسط في النحوس فهو الممتزج ، وما هو بثلاث نقط ، فهو عام النحوس . هكذا وجدته .والذي نراه في الحروف أنها ثلاثة عشر مهملة وخمسة عشر معجمة ، إلا أن يكون كان لهم اصطلاح في النقط تغير في وقتنا هذا .
وأما المعاني المنتفع بها من قواها وطبائعها فقد ذكر الشيخ أبو الحسن علي الحرالي والشيخ أبو العباس أحمد البوني والبعلبكي وغيرهم - رحمهم الله - من ذلك ما اشتملت عليه كتبهم من قواها وتأثيراتها ، ومما قيل فيها أن تتخذ الحروف اليابسة وتجمع متواليا ، فتكون متقوية لما يراد فيه تقوية الحياة التي تسميها الأطباء الغريزية ، أو لما يراد دفعه من آثار الأمراض الباردة الرطبة ، فيكتبها ، أو يرقى بها ، أو يسقيها لصاحب الحمى البلغمية والمفلوج والملووق . وكذلك الحروف الباردة الرطبة إذا استعملت بعد تتبعها ، وعولج بها ، رقية أو كتابة أو سقيا ، من به حمى محرقة ، أو كتبت على ورم حار، وخصوصًا حرف الحاء لأنها ، في عالمها ، عالم صورة ، وإذا اقتصر على حرف منها كتب بعدده ، فيكتب الحاء مثلاً ثماني مرات ، وكذلك ما تكتبه من المفردات تكتبه بعدده . وقد شاهدنا نحن ذلك في عصرنا ، ورأينا ، من معلمي الكتابة وغيرهم ، من يكتب على خدود الصبيان ، إذا تورمت ، حروف أبجد بكمالها ، ويعتقد أنها مفيدة ، وربما أفادت ، وليس الأمر كما اعتقد ، وإنما لما جهل أكثر الناس طبائع الحروف ، ورأوا ما يكتب منها ، ظنوا الجميع أنه مفيد فكتبوها كلها .
وشاهدنا أيضًا من يقلقه الصداع الشديد ويمنعه القرآن ، فيكتب له صورة لوح ، وعلى جوانبه تاءات أربع ، فيبرأ بذلك من الصداع .وكذلك الحروف الرطبة إذا استعملت رُقى ، أو كتابة ، أو سقيا ، قوت المنة وأدامت الصحة وقت على الباه ؛ وإذا كتبت للصغير حسن نباته ، وهي أوتار الحروف كلها ؛ وكذلك الحروف الباردة اليابسة ، إذا عولج بها من نزف دم بسقي ، أو كتابة ، أو بخور ، ونحو ذلك من الأمراض .وقد ذكر الشيخ محيي الدين بن العربي ، في كتبه ، من ذلك ، جملاً كثيرة . وقال الشيخ على الحرالي – رحمه الله - : إن الحروف المنزلة أوائل السور وعدتها ، بعد إسقاط مكررّها ، أربعة عشر حرفًا ، وهي : الألف والهاء والحاء والطاء والياء والكاف واللام والميم والراء والسين والعين والصاد والقاف والنون ، قال : إنها يقتصر بها على مداواة السموم ، وتقاوم السموم بأضدادها ، فيسقى للدغ العقرب حارها ، ومن نهشة الحية باردها الرطب ، أو تكتب له تجري المحاولة في الأمور على نحو من الطبيعة ، فتسقى الحروف الحارة الرطبة للتفريح وإذهاب الغم ؛ وكذلك الحارة اليابسة لتقوية الفكر والحفظ ، والباردة اليابسة للثبات والصبر ، والباردة الرطبة لتيسير الأمور وتسهيل الحاجات وطلب الصفح والعفو .
وقد صنف البعلبكي في خواص الحروف كتابًا مفردًا ، ووصف لكل حروف خاصة يفعلها بنفسه .وخاصية بمشاركة غيره من الحروف على أوضاع معينة في كتابه ، وجعل لها نفعًا بمفردها على الصورة العربية ،ونفعًا بمفردها إذا كتبت على الصورة الهندية ، ونفعًا بمشاركتهما في الكتابة ؛ وقد اشتمل من العجائب على ما لا يعلم مقداره إلا من علم معناه .
وأما أعمالها في الطلسمات فإن لله سبحانه وتعالى فيها سرًا عجيبًا ،وصنعًا جميلاً ، شاهدنا صحة أخبارها ،وجميل آثارها" ([26]).
وسأتوقف عند واحد ممن أشار إليهم ابن منظور في نصه السابق ، وهو أبو العابس أحمد البوني ( المتوفى سنة 622هـ) في كتابه ( منبع أصول الحكمة) حيث نرى عددًا من الرسائل والفصول تصب في خصائص الحروف وأسرارها حيث تستخدم حسب طرق تُشرح رياضيًا وعدديًا في الأدعية والتبرك وتحقيق المطالب ،مع حرق البخور والسقيا والرقيا أو التعويذات المنقولة في الجسد في قلادة أو سوار ، أو المدفونة في مكان ما مخصوص .وفيه يشير إلى مصادر ومؤلفات يعتد بها ويصلها في أسانيدها ومتونها في هذا العلم ـ كما يصفه ـ إلى بعض الفلاسفة كأرسطو وأفلاطون وبعض الهرامسة والأولياء والمتصوفة . ([27])
وسأكتفي بعرض ثلاثة نصوص من هذا الكتاب تلقي بعض الضوء على هذا النوع من التأليف والممارسة للاستفادة من الحروف في المعالجات ومختلف الأغراض . يقول البوني : " واعلم أن الوفق إذا كتب في وقت مناسب له قويت روحانيته وتضاعفت قوته .فمن المناسب لأوقات الكتابة الطالع من البروج للعمل من خير وشر ... ومن المناسب لأوقات الكتابة أن تنظر الغالب من الطبائع على حروف الاسم أو الآية المنزول بأعدادها في الوفق ناريًا كان أو ترابيًا أو هوائيًا , أو مائيًا ، وتأخذ الطالع من البروج المناسبة لذلك الطبع وتكتب فيه الوفق بشرط أن يكون الوفق مناسبًا للعمل أيضًا كالمثلث لأعمال الخير وتيسير الأعمال العسرة كإطلاق مسجون ، وتسهيل الولادة ، ودفع الخصومة ،والظفر بالعدو ،والأمن من الغرق ، وابتداء الأعمال ، وذهاب ريح القولنج . والمربع لأعمال الخير كالمحبة والجذب ،ومنع التعب ، والنصرة على الحرب " ([28])
أما الوفق الذي ذكره في مطلع النص السالف فيخصه بالتعريف في موضع آخر ، وأذكره هنا لما أريد لفت النظر إليه من اشتغال هؤلاء في ضوء قواعد في الجبر والحساب وربطها مع القيم العددية للأرقام ضمن قواعد وأصول تبدو من الخارج كعلم مستقل. يقول تحت باب سماه: ( التحفة الثامنة في الكلام على وضع الأوفاق وتنزيل الأعداد فيها واستنطاقها على ما ذكرته الهرامسة عن إدريس - عليه السلام - ) يقول : " إن أسماء الأوفاق تطلق على اللفظية والحرفية والعددية ويسمى وفقًا لموافقة أضلاعه وجهاته وأقطاره وأيضًا لموافقته في الأعمال : أي وجود التأثير منه والغرض منها هو العددي والحرفي ، وأما اللفظي فلا يطلق عليه اسم وفق إلا على طريق المجاز والأوفاق العددية على ثلاثة طرق : تأليفي وهندسي ومشترك ، فلفظة مشترك اصطلح عليها علماء هذا الفن من المتأخرين والأعداد المنزلة في المربعات على وجوه : ما يبتدأ فيها بالواحد والتفاضل واحد وهذا يسمى طبيعيًا ، وكذلك إذا كان الابتداء بالواحد والتفاضل بغير الواحد كالتفاضل باثنين مثلاً فلا يكون التفاضل فيه بأكثر من ذلك ولا أقل فيحصل الخلل في وضع ذلك المربع ، وتارة يبتدأ فيها بغير الواحد والتفاضل بالواحد ، ولا بد في هذا كله من معرفة فضل أكبر عدد في الوفق على أصغر عدد فيه ، والطريق في ذلك أن تضرب التفاضل الذي تريد في عدد بيوت الوفق إلا واحدًا فما خرج فهو فضل الأكبر على الأصغر" . ([29])
وفي موضع آخر يربط هذه الحروف وتأثيرها بأنواع المعادن ومناسبة بعض المعادن لبعض الحروف وسرعة تأديتها لأعمالها !! يقول موثقًا لمعلوماته ولنصائحه بذكر أسانيده محيلاً إلى أفلاطون وسقراط وغيرهما :
"وقال أفلاطون لا تحتاج المعادن إلى تطهير عند الرقم في الأعمال وإنما إذا أردتم ذلك فضعوا ما اتفق فيما اتفق فتطهير الأجساد لا يكون إلا عند إلقاء الإكسير ، وأثبتوا أصولكم في طبع عنصرها الغالب عليها ، وحرروا قدر الموازين والعائد ، وخذوا أرواح أصولكم فهي الأقسام على أعمالكم ، ووزعوها كما توزعوا الأعداد في المربعات . وإن شيءتم فالأجساد ، واختار ذلك الأسباط في أول الأصول ، واختار الأرواح في الأصول ، وأثبتوا خلف أصولكم الدائرة الطلسمية ،وصوروا ركني أعمالكم داخلها وزوايا أصولكم وأقطابها خارجها ، وطبعها الغالب مستكعبًا بالمطلوب وأعدادًا بالطالب ، واحرصوا على الأوقات والزايرج والمحل ، ولا تثبتوا أعمال الخير في مكرور كوكب نحس ، والغرض أن لا تضادوا الأعمال ، ولكن ناسبوها ،وكافئوها بالمراتب والدرج على توالي موازين هرمس عليه السلام تظفروا فيها بالنجاح ودوام التأثير والسر ، فنبه على أن المعادن لا تحتاج إلى تطهير وإنما تنتقى عند التدبير وهو إلقاء الإكسير لتكون قابلة له ملائمة في الطبع ، ونبه على أن الأرواح التي تنتظم من الأصول هي القسم الذي يقسم به على الأعمال ، وأن الأعوان أجود ما يكون نظمها بالحروف ، وعزا ذلك إلى الأسباط . وقال سقراط في لسان الحكمة : النصح إلى الحكيم من الواجب اللازم في حقه لإخوانه وحرام على غير أهله، والذي استعمله الأسباط ،ونقلوه عن هرمس هو تطهير الفلزات المعدنيات لقبول أسرار الحروف، وهو أولى من قبول سر الإكسير ، إذ أسرار الحروف هي الإكسير الأكبر الذي يقلب أعيان الطرد جلبًا والعداوة محبة والقريب بعيدًا والبعيد قريبًا . فالتطهير للفلزات واجب في هذا الفن فكلام سقراط أفصح من قول أفلاطون المتقدم خصوصًا إذا نقش فيها أوفاق مخصوصة بها ، فإن الأعداد سر من أسرار الله - سبحانه وتعالى - ، فلا يمكن إذاعته ، ولا ينبغي تضييعه ، ولا إذاعته للجهلة الفسقة ، فالحق ما ذكره سقراط من أن المعادن تنقى لوضع الأعمال ، والحق في قول أفلاطون إن الأرواح تنظم من الأصول أقسامًا ، والأعوان لا تنظم إلا بالحروف ،وما ذكره ذومقراط([30]) في مقالته هو هذا بعينه ، ولكن قال إذا نظمت أعوان الأعمال أجسادًا أضفنا لها السر الأكبر لتكون كاملة في الشكل واللفظ والمعدن للحرف والأعداد كالجسد ، فإذا لم يكن الجسد منقى لم تقبله الروح التي هي للحروف وأعدادها فذكر هذا الحكيم وغيره أن الفلزات لابد من تطهيرها لقبول أسرار الحروف والأعداد من أجل أن هذا الفن أشرف فنون الحكمة بإجماع الحكماء الأول فتعظيم الحكمة عند أهل الحكمة من الواجبات اللازمة لهم في ذلك " ([31]).
ترى ما الذي يمكن أن تستثيره في الذهن نصوص كهذه تستند إلى معتقد روحاني باطني لخصائص الحروف والكلمات وقدراتها ، معتقد يتكئ ويطور ويمزج عالم الروحانيات بالطب والأحياء والرياضيات والفلك والتنجيم ؟
إن هذا الجو المشبع بالتداخلات والامتزاجات الذي يعكس رؤية ضمنية لقانون ما جامع للتناسبات والذي يعكس أدوات وقوانين معرفية معينة للتعامل مع الوجود في ذلك الوقت المبكر مصورًا شرائح من الحياة الذهنية والحياة اليومية التي واجهها الناس قديمًا ، والتي يواجه الناس في عصرنا المشكلات ذاتها بالطرق والأساليب ذاتها ، بحيث تبدو مشاهد الحياة اليومية المعاصرة وكأنها شريحة لا تختلف كثيرًا عما يثيره ويهتم به البوني وأضرابه - هذا الجو أعادني مباشرة إلى جو مشابه لفت نظري في كتاب ( الكلمات والأشياء ) لميشال فوكو ، وعلى وجه الدقة ذلك الفصل المعنون بنثر العالم ، حيث كان يشرح ويؤكد مقولة التشابه ، التي تجمع أشياء العالم وتحركه حسب منطقها ، والتي ألح على أنها كانت حتى نهاية القرن السادس عشر قد لعبت دور الباني في المعرفة الثقافية الغربية ، يقول : "وليس ثمة تشابه بلا توقيع ، وعالم التشابه لا يمكن أن يكون إلا عالمًا مطبوعًا بعلامة معينة ... إن معرفة المتشابهات تقوم على كشف هذه التوقعيات وفك رموزها ... إن نسق التواقيع يقلب علاقة المرئي باللامرئي . لقد كان التشابه هو الشكل اللامرئي ... ولهذا فإن وجه العالم مغطى بالشعارات والحروف والأرقام والكلمات الغامضة وبالهيروغليفيات " ([32])
ويتابع في الفصل نفسه مواصلاً الحفر حول مقولة التشابه : " ويبدو لنا أن معارف القرن السادس عشر كانت مؤلفة من خليط متقلب من المعرفة العقلية ومن مفاهيم مشتقة من ممارسات السحر ، ومن تراث ثقافي كامل ضاعف اكتشاف نصوصه القديمة من قدرات سلطته " ([33]) .
ويعقب مؤكدًا : " إن التنجيم ليس شكلاً منافسًا من المعرفة ، إنه يشكل جسمًا واحدًا مع المعرفة نفسها ، والحال إن الإشارات التي تُؤوّل لا تدل على الخفي إلا بمقدار ما تشبهه ولا يؤثر المرء على العلاقات دون أن يصل تأثيره في الوقت نفسه إلى ما هو بها قد أشير إليه بشكل سري" ([34]) .
ثم يورد تساؤل باراسيلس ([35]) " قل إذن لم تفهم الحية في سويسرا والسويد الكلمات اليونانية أوسي ، أوسيا ، أوسي ... في أية أكاديمية تعلمتها لكي تدير فور سماعها لها ذنبها كي لا تسمعها من جديد ؟ وبالكاد تسمع الكلمة حتى تبقى – رغمًا عن طبيعتها ونباهتها – ساكنة لا تسمم أحدًا بجرحها السام ،ولا تقولن إن ذلك يأتي فقط من أثر وقع الكلمات المنطوقة ، فإن أنت كتبت في الوقت المناسب هذه الكلمات وحدها على ورق وفرضتها على الحية فإن هذه لن تظل أقل سكونًا مما لو كنت نطقت بها بصوت عال"([36]) .
ويعقب مؤكدًا :" إن مشروع السحر الطبيعي الذي يحتل مكانًا واسعًا في نهاية القرن السادس عشر ويتقدم حتى وقت متأخر في وسط القرن السابع عشر ليس أثرًا متخلفًا في الضمير الأوروبي ، لقد بعث من جديد -كما يقول ذلك بوضوح كامبانيلا Campanella ولأسباب معاصرة لأن التشكل الأساسي للمعرفة كان يعيد العلامات والمتشابهات بعضها للبعض الآخر. إن الشكل السحري كان ملازمًا لطريقة المعرفة " ([37]) .
ويشير بعد ذلك كيف أن اللغة -كما يرى - هي جزء من التوزيع الكبير للمتشابهات والتوقيعات ( ولاحظ هذه التقاطعات والتداخلات بين رؤية فوكو وما جاء في نصوص ابن عرب والبوني وغيره ) وأنها يجب أن تدرس كشيء من الطبيعة .ويتوقف عند راموس قائلاً :" لقد قسم راموس نحوه إلى جزأين : كرس الأول لأصل الكلمات الأمر الذي لا يعني أنه بحث فيه عن المعنى الأصلي للكلمات وإنما عن ( الخواص ) الباطنية للحروف والمقاطع وأخيرًا الكلمات بأكملها .يعالج الجزء الثاني الصرف أو علم التراكيب وكان يقصد أن يعلم " بناء الكلمات فيما بينها بواسطة خواصها" ([38]) .
ويعقب فوكو مؤكدًا على هذه الخصائص الباطنية للحروف : "إن دراسة النحو في القرن السادس عشر تقوم على نفس الترتيب المعرفي الذي اعتمد عليه علم الطبيعة أو الفروع الباطنية ، والاختلافات الوحيدة هي أن ثمة طبيعة واحدة وعدة لغات ، وفي الباطنية تنكشف خواص الكلمات والمقاطع والحروف بخطاب آخر يبقى من ناحيته سريًا ، في حين أن في النحو تعلن الكلمات والجمل اليومية من تلقاء ذاتها عن خواصها . إن اللغة هي في منتصف الطريق بين الأشكال المرئية للطبيعة والتوقعات السرية للخطاب الباطني ... ومن المؤكد أن اللغة لم تعد هي الطبيعة في مرئيتها الأصلية ، ولكنها ليست كذلك الأداة السرية التي يعرف عدد ضئيل من ذوي الامتياز فقط قدراتها ، إنها بالأحرى صورة عالم يفتدي نفسه حين بدأ يصغي للكلمة الحقيقية " ([39]).
ألسنا نرى في هذه النصوص المتفرقة المجتزأة من كتاب فوكو عددًا من التماثلات في المعتقد بأثر الكلمة وقواها الفاعلة ، وبالتأكيد على خصائص الحروف الروحانية الباطنة بما يشبه ما أشار إليه ابن منظور ومن قبله البوني وابن عربي ، وفيما أشار إ ليه البوني خاصة من الطاقات والقوانين التي سخرتها معرفة القرن السادس الهجري لاكتشاف مفاتيح الوجود وتحقيق مآرب الإنسان البسيط بالشفاء ونيل الأماني والمطامع متوسلاً بالتعاويذ والطلاسم والسحر والأعمال ، إذا ما سُدّت أمامه أبواب المعرفة والطب العقلاني ؟
ألا يشبه ذلك فعلاً ما قاله فوكو في الفصل نفسه : " فإن العرافة والتبحر [ أي التبحر في العلم العقلاني ] هما علم تأويل واحد ولكن ينمو وفق أشكال متشابهة على مستويين مختلفين : أحدهما يذهب من العلاقة الخرساء إلى الشيء نفسه ( ويجعل الطبيعة تتكلم ) والآخر يذهب من الخط الكتابي الساكن إلى الكلمة الواضحة (إنه يحيي اللغات النائمة) ... بين العلامات والكلمات ليس هناك الاختلاف القائم بين الملاحظة والسلطة المقبولة بين ما يمكن التحقق منه والتراث . ليس هناك في كل مكان سوى لعبة واحدة : لعبة الإشارة والشبيه ،ولذلك فإن الطبيعة والكلمة يستطيعان أن يتقاطعا إلى ما لا نهاية مشكلين – لمن يعرف القراءة – نصًا كبيرًا واحدًا" ([40])
أليس هذا النص الوجودي الذي يشير إليه فوكو من خلال قراءته وحفرياته في أعمال هؤلاء الذين يدرسهم هو نفسه النص الوجودي الكبير الذي جهد من قبلهم المتصوفة في الإشارة إليه وفي التنبيه إلى كلام الله المبثوث في الكون ، الذي لابد من الاجتهاد في فك رموزه وتوقيعاته وشاراته للتعرف والمعرفة تمهيدًا للوصول إلى أقصى مقامات العارف وغاياته ؟!
* * *
وبعد ، ها قد اتضح كيف أن هذه التيمة ، سواء أكانت في لغة الجسد أم في جسد اللغة ، تدور على محور المقدس والمغيّب والسحري ، واتضح أن منظومة الممارسات في لغة الجسد أو جسد اللغة تبدو وكأنها عملية تشفير لمغيّب ضمني حول ذاك السحري أو المقدس أو المطلق.
وهذه التيمة تستمد – كما هو ملاحظ – قوتها وفاعليتها من الصلة التي تعقدها بالغيب والمقدس ، لكنها لابد أن تمر بسلسلة وسائط ، وهذه الوسائط قد تمر عبر جسد الآخر ، أو عبر طاقته الشافية من خلال قبلة أو نفثة أو لمسة ، من تلك المعابر ومن خلال التماس مع الآخر الذي هو بدوره يمثل وسيطًا أو معبرًا يربط بالغيب والماوراء ، حيث يتحول جسد الآخر إلى آخر يتقمص دور الإله أو يوصل إليه . ولعله من هنا يأتي مصطلح التعويذة الرُقيا ، فكلمة يعوذ لغويًا من الالتجاء والاعتصام بمن يُلاذ به ، ولا يلوذ أحد بأحد أو بشيء إلا وهو يعتقد بأنه يمكن أن يعصمه ويحميه !
أما الرقيا فتعطي معنى التعويذ نفسه ، لكن ينضاف إليها أن الجذر اللغوي للرقى له معنى الصعود أصلاً ، وحينما يتعلق الأمر بكتابة وقراءة كلام مقدس فكأنما تكون المعوذات والرقى واسطة صعود وانتقال من المرض إلى الشفاء بالتعلق الروحاني والحبل الإلهي ، وتكاد تصبح الرقى ذاتها صنمًا يقرب إلى الله زلفى !! أو كأنما تتحول الكتابة وقراءة الكلام المقدس إلى معراج ؛ ففوق الطاقة الشافية للكلام يتحول الكلام إلى وسيلة ترق وصعود يوصل أو يربط بالماوراء وبالإله ، حتى إنه يمكن أن تتحول التعويذات والرقى إلى مطلق بذاتها . ولعله من هنا جاء النهي النبوي حيث قال : " ما توكل من استرقى " . وقد وردت أحاديث في النهي عنها خوفاً من الطابع الشركي الذي تحمله أو قد تؤدي إليه ([41]) .
وسلسة الوسائط هذه تمر عبر رموز تمثله وفق نظام علاقات تراتبي يحكمه خطاب الاعتقاد إيديولوجيًا ونفسيًا ، فالأم أو الأب الذي يقبل طفله قبلة التسكين والإبراء ، أو الرجل العاشق الذي يقبل قبلة الإحياء كما في الأسطورة ، أو الشيخ القارئ أو من يمارس السحر والشعوذات ، كلهم يتحركون من مواقع فوقية .كل هؤلاء وسائط التيمة ، وتيمة الشفاء تمر عبر هذه السلسلة من الوسائط من ضمن موقعها التراتبي الذي يحكمه منطق الإيمان بالقدرة والهيمنة التي تحقق الشفاء عبر لغة الجسد أو جسد اللغة . هاتان اللغتان اللتان تلتحمان أحيانًا وتتماهيان لتحقيق البغية والمطلوب من هذا الاعتصام ، من التعويذ إما بالجسد أو باللغة ، حتى إنه تبدو من التحامهما ( خاصة حينما يعمد إلى تذويب جسد اللغة ليسري في الجسد أو محوه وطمس معالم الفحوى والمعنى والنظام اللغوي والدلالي إجمالاً ) - تبدو حركة لإعادة اللغة ضمن الطبيعة، ضمن لغة الجسد لتصبح مجرد جزء من الطبيعة تساهم في إعادة نظام الجسد المختل بالمرض ونوازع الفناء !!
إن هذا الموضوع يتعلق بوجه من وجوه تعرف الإنسان على الكون وعلى نفسه وعلى الآخرين ، وعلى طريقة رؤيته له وعلى الأداة التي يتعامل بها للتعرف والرؤية ،وعلى الطريقة التي يحتمي من خلالها مما يتنازعه في هذا الوجود من قسوة وشرور ، ومن حب أو شراسة ، ومن اقتدار أو انكسار ، وطرق مواجهته للانكسار والألم . أو على الأقل ، خوفه وتوهمه من هذا الانكسار والألم . أليس الموت والمرض والألم وفراق الأحبة كلها نوازع فقد وانكسار وهذا ما يفسر كيف تأتي إشارات لغة الجسد ( الرائحة واللمسة والقبل ... ) وشفرات وتعويذات جسد اللغة لتكون كافية في الوعي واللاوعي الشعبي والموروث أيضًا كوسائل مُواجهةِ للانفصال وللغياب والفقد والموت !
لذا فإن الذي تعكسه تيمة الشفاء من وراء ظاهر هذه الممارسات وسلوك الكلام ليس الخوف من المرض والألم والموت فقط ، وإنما تعكس أيضًا الرؤية تجاه الوجود والإنسان وموقفه من الوجود وما وراء الوجود ، طموحاته وتخوفاته، وإمكاناته وحدود قدراته .
إن هذه التيمة تطرح بشكل قوي الرهان على قوى الإنسان حتى وإن كانت عبر وسائط ، إنها تربطه بأسرار الكون التي لابد أن يفك شفراتها حتى يفك أغلال بؤسه ويأسه وضعفه ، لأنها تشرع نافذة القدرات على الإمكان ومقاومة عوامل الفناء والموت . وكأنما هي تلح على مركزية الإنسان من خلال إعادة النظر في مجمل العلاقات التي تربطه بالكون وبأشيائه وبالمطلق أيضًا حيث يعكس تسخير الأشياء والاعتصام بالماوراء مسأله البقاء . فالبقاء هو الأهمية الضمنية أو المضمرة لضرورة استمرارية الإنسان ومركزيته في هذا الوجود .
المصادر والمراجــــع
أولاً : القرآن الكريم
ثانياً : الكتب
- ابن عربي ، محي الدين
- فصوص الحكم . شرح الأستاذ عبد الرازق القاشاني ( القاهرة ، مطبعة البابي الحلبي ط. الثانية 1386هـ - 1966م ) .
- الفتوحات المكية . تحقيق د. عثمان نجاني ( القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ط. الثانية سنة 1405هـ - 1985م ) .
- ابن كثير
تفسير القرآن الكريم ( بيروت ، دار المعرفة . ط. الثانية 1407هـ ) .
-ابن منظور
لسان العرب ( بيروت ، دار لسان العرب ، د.ت ) .
- الألوسي ، محمد شكري
بلوغ الأرب . شرح محمد بهجت الأثري ، ( القاهرة ، دار الكتب الحديثة ط. الثالثة ) .
- إيفريت ، بار بارا
أودن . ترجمة موسى بريزات ( بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط. الأولى 1978م ) .
- بروب ، فلادمير
مورفولوجيا الحكاية الخرافية . ترجمة وتقديم أبوبكر باقادر وأحمد عبد الرحيم نصر ( جدة, النادي الأدبي الثقافي ط. الأولى سنة 1409هـ ) .
- بوجان ، لويز
الشعر . ترجمة سلمى الخضراء الجيوسي ( بيروت ، دار الثقافة سنة 1961م ) .
- البوني ، أحمد
منبع أصول الحكمة ( بيروت ، المكتبة الثقافية ، د.ت ) .
- البيضاوي
تفسير البيضاوي ( بيروت ، دار الكتب العلمية 1408هـ ) .
- جلال الدين ، محمد بن أحمد وعبد الرحمن بن أبي بكر
تفسير الجلالين ( القاهرة ، دار التراث د.ت ) .
- فريزر ، جيمس
أدونيس أو تموز ، ترجمة جبرا إبراهيم جبرا ( بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط. الثالثة 1982م ) .
- فوكو ، ميشيل
الكلمات والأشياء . ترجمة مطاع صفدي وسالم يفوت وآخرين ( بيروت ، مركز الإنماء القومي سنة 1989 – 1990م ) .
ثالثًا المقالات والدوريات :
- جريدة الحياة ، العدد 21 فبراير سنة 1996م .
- جلبي ، خالص
مقالة " يد الإنسان " جريدة الرياض عدد 10125
- الطبال ، أحمد
مقالة " الماء في رمزيته الأسطورية والدينية " الفكر العربي المعاصر عدد 24-25 سنة 1983م .
- الوهيبي ، فاطمة
سلسلة مقالات في زاوية ذات في جريدة الجزيرة السعودية في الفترة ما بين 10/3/1416 إلى 5/6/1416هـ .
[1] - ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ( بيروت ، دار المعرفة ، ط.الثانية ، 1407هـ ) ج2/507.
[2] - تفسير الجلالين ( القاهرة ، دار التراث د.ت ) ج/1/191 ، تفسير البيضاوي ( بيروت ، دار الكتب العلمية 1408هـ) مج1/495 .
[3] - سبق لي أن تناولت هذا الالتباس والتداخل بين اللغتين ، لغة القميص وقميص اللغة ، في سلسلة مقالات نشرت في جريدة الجزيرة في الفترة ما بين 10/3/1416هـ إلى 5/6/1416هـ في ملحق الأحد .
[4] - د. خالص حلبي ، (يد الإنسان ) ، جريدة الرياض ع 10125 .
[5] - المصدر السابق .
[6] - تحمل الأساطير أيضًا قصصًا عن قبل سلبية ؛ كأن تتسبب قبلة مسحورة في أن ينسى أمير خطيبته كليًا ، وغيرها من القبل التي تحمل في جانب السلب والانتزاع وليس الخلق والإحياء والإبراء . ينظر مثلاً فلاديمير بروب : مورفولوجيا الحكاية الخرافية ، ترجمة وتقديم أبو بكر أحمد با قادر وأحمد عبد الرحيم نصر ( النادي الأدبي الثقافي بجدة ط1 ، 1409هـ ) ص 91.
[7] - لعله من الطريف ملاحظة أن كلمة قبلة الفصيحة تقابلها في عاميتنا النجدية كلمة ( حبة ) وهي مشتقة من الحب وتختصر الدلالات القصيا للقبلة في الاشتقاق من الحب وتحيل عليه في الوقت نفسه ، أما ما يشيع في اللهجات العامية الأخرى مثل ( بوسه ) فتعود في أصولها إلى الفارسية فهي كلمة معربة وليس عربية .
[8] - لويز بوجان ، الشعر ترجمة سلمى الخضراء الجيوسي سلسلة الأدب الأمريكي في نصف قرن ( بيروت دار الثقافة 1961) ص 224-225 .
[9] - باربار إيفريت ، أودن ، ترجمة موسى بريزات ( بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط . الأولى 1978م ) ص15.
[10] - سأعود في القسم الثاني من هذا البحث المعنون بجسد اللغة للحديث عن هذا المعتقد بالتفصيل .
[11] - جاء ذكر هذه الواقعة في خبر أوردته جريدة الحياة عدد 21فبراير سنة 1996م .
[12] - يمكن العودة للقسم الثاني من هذه الدراسة ( جسد اللغة ) تحت عنوان سقيا الكلام محو وإثبات ، فهناك حديث مفصل عن العزائم والمحو والإثبات .
[13] -محي الدين بن عربي ، فصوص الحكم ، شرح الأستاذ عبد الرازق القاشاني ( القاهرة ، مطبعة البابي الحلبي ، ط2 ، 1386-1966م . ص 220-221 .
[14] - جيمس فريزر ، أدونيس أو تموز ، ترجمة جبرا إبراهيم جبرا ( بيروت المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط 3، 1982م ) ص 134- 135 .
[15] - المصدر السابق ص 135 .
[16] - أما المعالجون والمشعوذون فهم يستندون في أعمالهم إلى حسابات ومعارف يعتقدون بها ، ويؤمنون بأنها علمهم الخاص الذي وهبوا إياه دون بقية البشر .ومن ينظر في الكتب المؤلفة للعلاجات بالطلسمات واستحضار الجن والأرواح يجد أن لهم قواعدهم وطرقهم في الحساب ومعادلة الحروف والأرقام واصطناع العزائم والرقى والطلسمات بأقدار وحسابات رياضية مدروسة .ينظر مثلاً كتاب منبع أصول الحكمة للبوني ( بيروت ، المكتبة الثقافية ، .د.ت ).
[17] - أحمد الطبال ، مقالة " الماء في رمزيته الأسطورية والدينية " ، الفكر العربي المعاصر عدد 24- 25 سنة 1983 ، ص 148 .
[18] - المصدر السابق ، ص 148 .
[19] - القرآن الكريم سورة الأنبياء آية 30 .
[20] - القرآن الكريم سورة هود آية 7 .
[21] - الماء في رمزيته الأسطورية والدينية ، ص 149 .
[22] - محمد شكري الألوسي ، بلوغ الأرَب ، شرح محمد بهجت الأثري ( مصر دار الكتب الحديثة ، ط3 ) ج 2/320 .
[23] - المصدر السابق ج 2/320 .
[24] - ابن عربي ، الفتوحات المكية تحقيق : عثمان يحيى ( القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب ط2 سنة 1405هـ -1985م) ج 1/237 .
[25] - المصدر السابق ج 1/260- 261 .
[26] - ابن منظور ، لسان العرب ( بيروت دار لسان العرب .د.ت ) حققه يوسف خياط ، المجلد الأول ص س
[27] - أحمد البوني ، منبع أصول الحكمة. ينظر أسانيده وإشاراته إلى عدد من هؤلاء في الصفحات من 20-25- وفي مواضع متفرقة من متن الكتاب ، وقد ختم الكتاب بفصل قصير خصصه لذكر أسماء مشايخه في هذا العلم كما سماه علم الحروف وعلم الباطن وعلم الأوفاق ،حيث يذكر سلاسل من أسانيد يعود بها إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعلي - رضي الله عنه- والحسن البصري والبسطامي وابن عربي ...
[28] - المصدر السابق ،ص : 62- 63 .
[29] - المصدر السابق ص 29 .
[30] - Democritus
[31] - المصدر السابق ص 28-29 .
[32] - ميشال فوكو : الكلمات والأشياء ترجمة مطاع صفدي وسالم يفوت وآخرين ( بيروت مركز الإنماء القومي ، 1989 – 1990م ) ص 46 .
[33] - المصدر السابق ص50 .
[34] - المصدر السابق ص50 .
[35] -باراسيليوس طبيب سوسيري شهير ( 1493- 1541 ) حين كان أستاذًا للطب في جامعة بال لقن كتابًا لابن سينا في الساحة العامة ، ولكنه طرد من المدينة في العام التالي ينظر كتاب الكلمات والأشياء ص 41 الحاشية .
[36] - المصدر السابق ، ص 50 .
[37] - المصدر السابق ص 50 – 51
[38] - المصدر السابق ص 52
[39] - المصدر السابق ص 52 – 53
[40] - المصدر السابق ص 51
[41] - هناك أحاديث في جانب النهي وأحاديث أخرى في جانب الإباحة ليس هذا مقام التفصيل فيها .